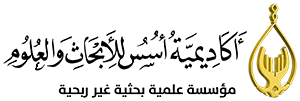أدب النفس.. والخلق المفقود
كتبه/ وائل سرحان
الحمد لله والصلاة والسلام على خير رسله وأفضل خلقه.. صلى الله عليه وسلم.
لقد أصبح معلومًا ومنتشرًا -بحمد الله- أن من مقاصد بعثة النبي تزكية النفس، وأنها غاية الرسالات السماوية، وفي الوقت نفسه هي ثمرتها.. ويأتي في القلب من زكاة النفس وتزكيتها حسن الخلق، فلقد حصر صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم مقصد بعثته فيه وقصرها عليه؛ فقال: (إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ)، وليست مكارم الأخلاق طقوسًا معتادة، كألفاظ محفوظة أو حركات معهودة، وهي ليست كذلك ابتسامة مصطنعة متكلفة تخفي وتداري تحتها من سوء الطوية وسوءات النفس ما تخفي وتداري!
إنما حسن الخلق ينبغي أن يكون طبعًا وسجية في المرء يعود إلى نقاوة نفسه وطهارة باطنه، إما جبلة خلق عليها أو عن رياضة ومجاهدة.
وتأمل قول أزكا النفوس وأتقاها صلى الله عليه وسلم: (أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحَاسِنُهُمْ أَخْلَاقًا، الْمُوَطَّئُونَ أَكْنَافًا) أو قال: (خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا، الْمُوَطَّئُونَ أَكْنَافًا).
فحسَن الخلق: سمح، سهل، لين الجانب، رفيق، مهذب، يعذر الناس ويعتذر لهم، الذي يحب الناس أكثر من حبهم له، لا يتأذى مَن يصاحبه أو يآخيه.. وهذه لا تأتي إلا عن طهارة طبع ورقة حس أو مجاهدة نفس.
ولذلك حرص السلف رضوان الله عليهم على (أدب النفس)، وهو ملاك حسن الخلق أو هو منه بيت القصيد، وموطن القلب من أدب النفس هو مخالفة الهوى.
لذا كانت وصية مالك رحمه الله لفتى من قريش (يا ابنَ أخي، تعلَّم الأدبَ قبلَ أنْ تتعلَّم العلم( [حلية الأولياء].
وهو ما درج عليه مالك وعليه تربى، فقد قال -رحمه الله -: (كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه) [ترتيب المدارك].
قد ينفع الأدبُ الأحداثَ في صغر وليس ينفع عند الشيبة الأدبُ
إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا يلين إذا قومته الخشبُ
فهذا الأدب الذي تأدب به مالك قد ورثّه تلامذته، فقال عبد الله بن وهب -رحمه الله-: (ما تعلَّمنا من أدبِ مالكٍ أكثرُ مما تعلّمنا من علمه)[ترتيب المدارك، وسير أعلام النبلاء].
وهذا هو شأن سلفنا الأماجد رضي الله عنهم، قال سفيان الثوري -رحمه الله-: (كان يقال حسن الأدب يطفئ غضب الرب عز وجل) [حلية الأولياء].
وقال عبد الله بن المبارك: قال لي مخلد بن الحسين: (نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث) [الجامع لأخلاق الراوي].
وقال الليث رحمه الله -وقد أشرف على أصحاب الحديث فرأى منهم شيئًا - فقال: (أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم)[الجامع لأخلاق الراوي].
وقال ابن المبارك عن نفسه: (طلبت الأدب ثلاثين سنة، وطلبت العلم عشرين سنة) [ترتيب المدارك]، وقال: (كانوا يطلبون الأدب قبل العلم).
وقال ابن الجوزي -رحمه الله-: (كاد الأدب يكون ثلثي العلم)[ صفة الصفوة].
(قال أبو النضر الفقيه: سمعت البوشنجي يقول: من أراد العلم، والفقه بغير أدب فقد اقتحم أن يكذب على الله ورسوله)[سير أعلام النبلاء].
قال ابن القيم رحمه الله: (أدب المرء: عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه: عنوان شقاوته وبواره.
فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب) [مدارج السالكين].
فعلى طلاب العلم أن يحرصوا على تأديب أنفسهم حتى يصير أدب النفس ونقاوة الباطن سجية وطبعًا أشد من حرصهم على حفظ المسائل واستظهارها.
فالانشغال بأدب النفس وتأديبها هو سمة الصلحاء المصلحين، فينبغي على من أراد زكاة نفسه أن (يحذر من نفسه أشد حذرًا من عدو قد تبينت عداوته، يريد قتله، أو أخذ ماله، أو انتهاك عرضه.
فإن عدوك الذي يريد قتلك، أو أخذ مالك، أو انتهاك عرضك، إن ظفر منك بما يؤمله منك فإن الله عز وجل يكفر عنك به السيئات، ويرفع لك به الدرجات، وليس النفس كذلك؛ لأن النفس إن ظفرت منك بما تهوى مما قد نهيت عنه، كان فيه هلكتك في الدنيا والآخرة)[أدب النفوس للآجري، بتصرف واختصار].
♦ وأبرز المواطن التي يظهر فيها أدب النفس وتظهر فيها الأخلاق المحمودة والمذمومة مواطن التعامل مع الخلق، عند غلبات الهوى، واختلاف الرغبات، وتعارض المصالح.
فمن الناس من يتعامل بمبدأ (الأنانية) والمنفعة الشخصية في تعاملاته وعلاقاته، يتعامل مع الناس وعينه على ما ينتفع به منهم، سواء كان في دين -أو هكذا يظن- أو في دنيا، فتصفو علاقته ويصح ودّه ويمد حبل وصاله طالما كانت مصالحه ومنافعه موصولة، وإذا انتهت مصلحته أو ظهرت رغبات النفوس وبان تعارضُ الأهواء واختلاف المصالح؛ ظهرت سوءات النفوس، وطلَّت أغراضها وأمراضها، وانقطع حبل الوصل والود، وانحل ما كان معقودًا بنفسه، وانبت ما كان موصولا بيده، وأضحى التنائي بديلًا من تدانيه، وناب عن طيب لقياه تجافيه.
وربما نسي ما كان مِن حب ووداد، ورأى كل حسنة من حسنات الإخلاص والوفاء سيئةً من سيئات الخديعة والمكر.. وليس هذا لا من أدب النفس ولا من حسن الخلق، إنما هو الهوى، و(الأنا) والنفعيّة.
وهذا هو مريض القلب قبيح النفس خبيث الباطن: إذا أحب أحب لهواه، وإذا أبغض أبغض لهواه، وإذا أعطى أعطى لهواه، وإذا منع منع لهواه.. أو فيه خصلة ذمها الله تعالى في كتابه، هي من سيما غير المؤمنين (فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ) [التوبة: 58]، فمن الناس من تكون هذه هي قاعدة تعاملاته.. شعر أم لم يشعر!
وربما غلّف ذلك بأغلفة زائفه وأوهام كاذبة من الدين والتقوى وحب الخير، فإذا ما انقضت لبانته ترك أخاه وصاحبه نسيًا منسيًّا.
♦ لذلك كان من الثلاث المنجيات (كَلِمَةُ الحَقِّ فِي الرِّضَا وَالغَضَبِ) [شعب الإيمان]، وكان من خصال الإيمان (القصْد في الرضا والغضب) [الإبانة]، وربما يظن ظان أن القصد أو كلمة الحق تصعب في حال الغضب تسهل في حال الرضا، إنما هو أمر صعب في الحالين كلتيهما، فمن الناس من إذا أحب أحدًا رفعه إلى الجوزاء، وكان مبطلًا في ذلك، كما قيل (حبك الشيء يعمي ويصم).
وكذلك إذا غضب أو انقضت مصالحه أو تعارضت الأهواء، رماه من علٍ كأنما يخرّ من السماء، ولم يرَ في أخيه وحبيبه السابق إلا كل عيب ونقيصه.
وكلا الأمرين ليس من القصد ولا من الحق.
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا
ولو تأملنا التوكيد الشديد في صفة من يجد (حلاوة الإيمان) الذي جاء في الحديث الشريف: (أَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ) بأسلوب النفي والاستثناء الذي يدل على القصر والحصر والتوكيد، فإنه لا يحبه لغرض أو إحسان أو لهوى، كموافقة طبع أو أنه يجد معه نفسه وراحته أو مصالحه، إنه التجرد، وليست النفعيّة.
حتى لو قدر الله الفراق بينهما فيكون الفراق لله، وليس لغرض أو هوى (وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ) وحينما يفترقان – مهما يكن سبب الفراق- تبقى المحبة (الدِّينية) الصادقة حال افتراقهما كما كانت حال اجتماعهما، ويحفظان الحب في الحضور والغيبة، والأصل أنهما يدومان (على المحبة الدينية ولم يقطعاها بعارض دنيوي، سواء اجتمعا حقيقة أم لا، حتى فرق بينهما الموت) [الفتح]، إنه القصد في كل حال، وليست النفعية.
فتمحّض المحبة بين الناس والعلاقات بينهم لله، والقصد في الرضا والغضب في المحبة والجفاء =أمر ليس بالسهل اليسير، فإنه يحتاج إلى رياضة ومجاهدة، وحسن خلق، وأدب نفس، فـ(عن عبدة بن أبي لبابة، عن مجاهد، قال: ما التقى مسلمان فتصافحا إلا غفر لهما ذنوبهما قبل أن يتفرقا، أو تحاتت عنهما ذنوبهما، قلت: إن ذلك يسير، قال: لا تقل ذلك، إن الله عز وجل يقول (لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ) [الأنفال: 63]، قال: فكان مجاهد أفقه مني) [حلية الأولياء]
وكما هو منسوب إلى يحيى بن معاذ - رحمه الله - أنه قال: علامة الحب في الله ألا يزيد بالبر، ولا ينقص بالجفاء.
وإن اعترض معترض على الشق الأول، فلن يكون اعتراض على أنه لا يحبه لحظ نفسه؛ فإذا كان في مصالحه ورغباته زاد حبه وقويت علاقته، وإذا عكس عكس، أو أنه يحبه لأنه يراه سلمًا لأحلامه، ويجافيه لأنه رآه عائقًا أمامه.
ولن يكون اعتراض كذلك أن يكون قصد في الرضا والغضب في الود وفي الجفاء.
وللحديث بقية – إن شاء الله – في الأسباب والعلاج.. والحمد لله رب العالمين.