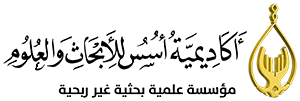الفرق بين منهج أهل السنة والأشاعرة في العقيدة
كتبه/ وحيد قطب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم.. وبعد
تمهيد:
شغل الاهتمام بأمر العقيدة الصحيحة الصافية أبناء العمل
الإسلامي، فعليها مدار سعادة الدنيا
والآخرة، ورفعة الأفراد والأمم، وكلما كانت العقيدة نقية
صافية كلما فتحت القلوب، وأضاءت العقول، وجمعت
شمل الأمة، وقد كان للعقيدة الصافية
أثر في تحول القبائل العربية المتناحرة إلى أمة واحدة أضاءت الدنيا بعقيدة التوحيد.
وذلك دليل على أن منهج الصحابة في فهم العقيدة والتعامل
مع مسائلها هو الأعلم والأحكم والأسلم، وأن طريقتهم هي طريق أهل السنة والجماعة، فالمنهج السلفي الصحيح منهج أهل السنة والجماعة مبناه
على طريقة الصحابة فهمًا وعملًا.
على سبيل المثال: الصحابة ╚ كانت لهم
طريقة ميسرة في التعامل مع النصوص الواردة في صفات الله U، يسيرة في ظاهرها عميقة في فهمها، قوية في أثرها، لما سمعوا قول النبي ♀: >يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ
وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ
الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي
فَأَغْفِرَ لَهُ<([1])، آمنوا بأن الله U ينزل، فكلام النبي ♀ بلغة عربية
واضحة، غير أنهم لم يسألوا كيف ينزل؛ إنه ينزل بكيفية
تليق بجلاله وكماله U، ولم يدخلوا
في معارك كلامية؛ هل ينزل ويخلو
منه العرش؟ أو ينزل ولا
يخلو منه العرش؟ فالله U قادر على أن ينزل ولا يخلو منه العرش، ينزل إلى كل ثلث
في ثلثهم، كما أنه ▐ يحاسب الناس
كلهم في صعيد واحد دون أن يشغله شخص عن شخص.
كل هذه الأمور وغيرها لم تشغلهم، فقدرة الله U وكماله
وعظمته لا يقدر قدرها إلا الله U.
لكن شغلهم رضي الله عنهم الغاية الأساسية من الحديث قول
المولى ﷻ: >مَنْ يَدْعُونِي، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي
فَأَغْفِرَ لَهُ< فوقفوا بين يدي الله U في ذلك
الوقت قيامًا منيبين، دعاة سائلين، ولكم خسر من فاته هذا المعنى وانشغل بكلام يشغله عن
مقصود الحديث، فضلًا عن خسران من
أنكر ذلك المعنى بنفى تلك الصفة، قس على ما سبق كل صفات الأفعال، بل كل صفات الله ﷻ ([2]).
تعريف أهل السنة والأشاعرة
أولًا: التعريف بأهل السنة والجماعة:
ذهب المحققون من أهل العلم إلى أن مفهوم السلف عند الإطلاق يراد به
الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان وأتباع التابعين من أهل القرون الثلاثة
الوارد ذكرهم في حديث عَبْدِ اللَّهِ ؓ،
عَنِ النَّبِيِّ ♀ قَالَ: «خَيْرُ النَّاسِ
قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ
أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ،
وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ»([3]). ومن
سلك سبيلهم من الخلف وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله ومن قال بقوله ([4]).
ومصطلح أهل السنة له إطلاقان: عام وخاص: فالمراد بالعام؛ ما يكون في مقابل الشيعة، فيدخل فيه من عداهم من الفرق الإسلامية كالأشاعرة والماتريدية. وعليه يصح تقسيم المسلمين
إلى سنة وشيعة.
والمراد بالخاص: ما يكون في مقابل أهل البدع، والمقالات المحدثة، كالشيعة، والخوارج، والجهمية، والمعتزلة، والمرجئة، والأشاعرة، والماتريدية وغيرهم، فهؤلاء لا يدخلون في مفهوم
أهل السنة بالإطلاق الخاص.
قال شيخ الاسلام ابن تيمة ؒ: > فلفظ (أهل السنة) يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة، فيدخل في ذلك جميع الطوائف
إلا الرافضة، وقد يراد به أهل الحديث والسنة
المحضة، فلا يدخل فيه إلا من يثبت
الصفات لله تعالى ويقول: إن القرآن غير مخلوق، وإن الله يرى في الآخرة، ويثبت القدر، وغير
ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة<([5]).
ثانيًا: التعريف بالأشاعرة:
الأشاعرة هم المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري ؒ في الاعتقاد([6])، وهو قد مر بمراحل في
اعتقاده، وبعد أن اكتملت أطوار المذهب
الأشعري أصبح على قسمين:
1- المتقدمين. 2-
المتأخرين.
والمتأخرون وإن كانوا يصرحون بأنهم على اعتقاد عقيدة أبي
الحسن الأشعري، إلا أن هناك مسائل كثيرة
جدًا يخالفون فيها إمام المذهب ومتقدميهم، ومنها ما يصرح الأشعري ببدعيته وكفره؛ كإنكار المتأخرين علو
الله تعالى، أو أن القرآن المتلو ليس
بكلام الله تعالى، ونحو
هذا، فانحرف المتأخرون عن مسلك
أبي الحسن في أصول الدين إلى مسلك آخر، زادوا فيه وأوغلوا([7]).
وأول من يشار إليه من المتأخرين الجويني والغزالي وأبو
بكر ابن العربي والشهرستاني والرازي والآمدي([8])، ممن زاد في التأويل وتوسع
في إدخال القواعد الكلامية والتصوف.
المراحل الاعتقادية التي مر بها أبو الحسن الأشعري:
المرحلة الأول: المرحلة الاعتزالية:
وهذه المرحلة كان سببها ملازمته لشيخه أبي علي الجبائي زوج
أمه، واستمر على الاعتزال إلى سن
الأربعين، ثم فارقه لما لم يجد إجابات
كافية في مسألة الصلاح والإصلاح على الله تعالى، وقيل إنه رأى النبي ♀
مناماً، وأمره أن يروي العقائد المروية
عنه؛ لأنها الحق، ولهذا اعتمد الأدلة النقلية
في تقرير العقائد([9]).
قال ابن قاضي شهبة: >أخذ علم الكلام أولا عن أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة، ثم فارقه ورجع عن الاعتزال
وأظهر ذلك، وشرع في الرد عليهم والتصنيف
على خلافهم، ودخل بغداد وأخذ عن زكريا
الساجي<([10]).
المرحلة الثانية: المرحلة الكلابية:
قال ابن خلكان: >وكان أبو الحسن الأشعري أولاً
معتزليًّا، ثم تاب من القول بالعدل وخلق
القرآن في المسجد الجامع بالبصرة يوم الجمعة، ورقي كرسياً ونادى بأعلى صوته: من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي، أنا فلان بن فلان، كنت أقول بخلق القرآن وأن
الله لا تراه الأبصار وأن أفعال الشر أنا أفعلها، وأنا تائب مقلع، معتقد للرد على المعتزلة مخرج لفضائحهم ومعايبهم<([11]).
عاش أبو الحسن الأشعري في آخر المرحلة الاعتزالية حيرة كبيرة، وقد اختفى مدة عن الناس خالياً
بنفسه ليعرف الحق، ومال
إلى طريقة ابن كلاب، وابن
كلاب جاء في زمان كان الناس فيه صنفين: فأهل السنة والجماعة يثبتون الصفات كلها الذاتية والفعلية، والجهمية ينكرونها، فجاء ابن كلاب وأثبت الصفات
الذاتية، ونفى ما يتعلق منها بالمشيئة، فلذلك قرر الأشعري هذه العقيدة. وقد يمثل هذه المرحلة كتابة
(اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع)([12]).
والأشعرية تعد هذه المرحلة آخر مراحل أبي الحسن الأشعري.
المرحلة الثالثة: المرحلة السنية:
هذه المرحلة يمثلها كتابه (الإبانة) الذي بين في مقدمته أنه
ينتسب إلى الإمام أحمد بن حنبل في الاعتقاد. وكذلك كتابه (مقالات الإسلاميين)([13]).
أدلة وصول أبي الحسن الأشعري إلى هذه المرحلة
يدل على ثبوت هذه المرحلة الأخيرة أمور:
أولا: أنها مرحلة قد أثبتها المؤرخون، منهم الحافظ ابن كثير والحافظ الذهبي وهما من هما في التاريخ وسعة الاطلاع.
قال ابن كثير رحمه الله: >ذكروا للشيخ أبي الحسن الأشعري
ؒ ثلاثة أحوال:
أولها: حال الاعتزال، التي
رجع عنها لا محالة.
والحال الثاني: إثبات الصفات العقلية السبعة، وهي: الحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام، وتأويل الجبرية كالوجه، واليدين، والقدم، والساق، ونحو ذلك.
والحال الثالثة: إثبات ذلك كله من غير تكييف، ولا تشبيه، جريا على منوال السلف، وهي طريقته في الإبانة التي صنفها آخرا، وشرحه القاضي الباقلاني، ونقلها أبو القاسم ابن عساكر، وهي التي مال إليها الباقلاني، وإمام الحرمين، وغيرهما من أئمة الأصحاب المتقدمين، في أواخر أقوالهم<([14]).
وقال الذهبي
ؒ: >رأيت لأبي الحسن أربعة تواليف
في الأصول يذكر فيها قواعد مذهب السلف في الصفات، وقال فيها: تمر كما جاءت. ثم
قال: وبذلك أقول، وبه أدين، ولا تؤول<([15]).
وقال في كتابه (العرش): >وكان معتزليًّا ثم تاب، ووافق أصحاب الحديث في أشياء
يخالفون فيها المعتزلة، ثم وافق أصحاب الحديث في أكثر ما يقولونه، وهو ما دوناه عنه من أنه نقل إجماعهم على ذلك، وأنه موافق لهم في جميع ذلك، فله ثلاثة أحوال: حال كان معتزلياً، وحال كان سنياً في البعض دون
البعض، وحال كان في غالب الأصول سنياً، وهو الذي علمناه من حاله، فرحمه الله وغفر له ولسائر
المسلمين<([16]).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ؒ: >وكنت أقرر هذا للحنبلية -
وأبين أن الأشعري، وإن
كان من تلامذة المعتزلة ثم تاب، فإنه كان تلميذ الجبائي ومال إلى طريقة ابن كلاب وأخذ عن زكريا الساجي أصول
الحديث بالبصرة، ثم لما قدم بغداد أخذ عن حنبلية
بغداد أمورا أخرى، وذلك
آخر أمره كما ذكره هو وأصحابه في كتبهم<([17]).
ثانياً: أن ما قرره أبو الحسن الأشعري في (الإبانة) و(مقالات الإسلاميين) من مسائل المعتقد
ومنه صفات الله تعالى موافق لمعتقد السلف، ومخالف لما عليه الأشاعرة؛ إذ إنه قد أثبت الصفات لله تعالى على ظاهرها، ومنع من تأويلها، وعد من تأولها مبتدعة وجهمية.
قال في كتابه (الإبانة) الذي هو آخر مؤلفاته بعد كلام طويل: >قولنا الذي نقول به، وديانتنا التي ندين بها، التمسك بكتاب الله ربنا عز وجل، وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما روى عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد
الله أحمد بن محمد بن حنبل - نضر الله وجهه ورفع درجته
وأجزل مثوبته - قائلون، ولما خالف قوله مخالفون؛ لأنه الإمام الفاضل، والرئيس الكامل، الذي أبان الله به الحق، ودفع به الضلال، وأوضح به المنهاج، وقمع به بدع المبتدعين، وزيع الزائغين، وشك الشاكين، فرحمة الله عليه
من إمام مقدم، وجليل معظم، وكبير مفهم<([18]).
ويؤكد هذا: قول بعض الطاعنين في أبي الحسن الأشعري أنه إنما ألف (الإبانة) وقاية لأهل السنة...!!
ففي الفتاوى الكبرى: >وقال ابن عساكر فيما رده على أبي علي الأهوازي فيما وصفه من مثالب الأشعري: وقد ذكر أبو علي الأهوازي
أن الحنابلة لم يقبلوا منه تصنيف الإبانة.
قال الأهوازي: وللأشعري كتاب في السنة قد جعله أصحابه وقاية لهم من أهل السنة يتولون به العوام
من أصحابنا سماه " كتاب الإبانة " صنفه ببغداد لما دخلها. فلم يقبل ذلك منه الحنابلة
وهجروه.... [إلى أن قال]: وقول الأهوازي أن الحنابلة
لم يقبلوا منه ما أظهره من كتاب الإبانة وهجروه. فلو كان الأمر كما قال لنقلوه عن أشياخهم ولم أزل أسمع ممن
يوثق به أنه كان صديقا للتميميين سلف أبي محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز
بن الحارث<([19]).
وظاهر هذا يدل على أن كتاب (الإبانة) ليس على طريقة الأشاعرة، ولذلك ظن بعض الطاعنين فيه
أنه إما ألفه إرضاءً لأهل السنة، ووقاية لنفسه من إنكارهم عليه، وهذا الظن وإن لم يكن صحيحاً، إلا أنه يثبت أن منهج الأشعري في (الإبانة) موافق لأهل السنة، ومخالف للكلابية والأشعرية.
(1) منهج التلقي بين أهل السنة والأشاعرة
منهج أهل السنة في التلقي:
يقوم منهج أهل السنة والجماعة في التلقي على ما يلي:
1- يعتمد منهج أهل السنة في تلقي الاعتقاد على الكتاب والسنة؛ فالعقيدة توقيفية لا تثبت
إلا بدليل من الشارع، لا
مجال فيها للرأي والاجتهاد، قال ابن أبي العز الحنفي: «فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، والانقياد لأمره، وتلقي خبره بالقبول والتصديق، دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولا، أو يحمله شبهة أو شكا، أو يقدم عليه آراء الرجال
وزبالة أذهانهم، فيوحده بالتحكيم والتسليم
والانقياد والإذعان، كما
وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل»([20]).
2- قبول كل ما صح عن الرسول ♀ والاحتجاج به سواء أكان
متواتراً أم آحاداً في العقائد أو في الأحكام، خلافاً لجمهور المتكلمين الذين يردون أخبار الآحاد في الاعتقاد؛ فقد ظلت أحاديث النبي ♀ محل التسليم والقبول بدءاً من عهد الصحابة ╚ والتابعين وسلف الأمة الأخيار، من غير تفريق بين المتواتر
والآحاد، وبين ما يتعلق بأمور المعتقد
وما يتعلق بالأحكام العملية، فكان طريق العلم والعمل بها هو الخبر الصادق، وكان الشرط الوحيد في قبول الحديث هو الصحة، سواء قل رواته أم كثُروا، ولم يكونوا يطلبون أمرًا زائدًا
على الصحة، حتى ظهرت بدع الاعتقاد، وتأثر فئام من الناس بالمنهج
الفلسفي الكلامي، فأعملوا
عقولهم وآراءهم وقدموها على الوحي، وعلى كلام الله وكلام رسوله ♥، تحت دعوى تقديس الوحيين، وتعظيم الله وتنزيهه عما لا
يليق به.
والأدلة من الكتاب والسنة جاءت عامة في اتباع النبي ♀ والتحذير من عصيانه ومخالفة أمره، من غير تفريق بين أمور العقيدة
وأمور الأحكام كقوله تعالى: «وَمَا كَانَ
لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ
لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ
ضَلَالًا مُبِينًا» [الأحزاب: 36]، فقوله " أمراً
" عام يشمل كل أمر سواء أكان في العقيدة أم الأحكام، وقوله ▐: «فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ
تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» [النور: 63]، فلا وجه لتخصيص هذه الأدلة
بالأحكام دون العقائد.
وكان النبي ♀ يبعث عددًا
من أصحابه إلى أطراف البلاد ليعلموا الناس أصول الدين وفروعه، وأمور العقائد والأحكام، فأرسل علياً ومعاذاً وأبا
موسى وغيرهم من الصحابة، وفي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ مُعَاذًا ╚، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ♀، قَالَ: «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا
مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ
اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ
افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ،.. »([21]) الحديث، فأمره بتقديم الدعوة إلى العقيدة
والتوحيد على أركان الإسلام الأخرى، ولم ينقل أن أحداً من أولئك الرسل اقتصر على تبليغ الفروع والأحكام العملية
فقط، مما يؤكد ثبوت أمور العقيدة
بخبر الواحد وقيام الحجة به.
كما انعقد الإجماع على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقائد
والأحكام على السواء، قال
الإمام الشافعي: >ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة: أجمع المسلمون قديما وحديثاً على تثبيت خبر الواحد، والانتهاء إليه، بأنه لم يُعلم من فقهاء المسلمين
أحد إلا وقد ثبَّته جاز لي. ولكنْ أقول: لم
أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفتُ من أن ذلك موجودًا
على كلهم<([22]).
وحكى الإجماع على ذلك الإمام ابن عبد البر حيث يقول: « وأجمع
أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل
وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع على هذا جميع الفقهاء في كل
عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافا
وقد أجمع المسلمون على جواز قبول الواحد السائل المستفتي لما يخبره به العالم الواحد
إذا استفتاه فيما لا يعلمه وقبول خبر الواحد العدل فيما يخبر به مثله»([23]).
وقال الإمام ابن القيم ؒ: >وأما المقام الثامن: وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث وإثبات صفات الرب
تعالى بها، فهذا لا يشك فيه من له أقل
خبرة بالمنقول، فإن الصحابة هم الذين رووا
هذه الأحاديث وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول ولم ينكرها أحد منهم على من رواها، ثم تلقاها عنهم جميع التابعين
من أولهم إلى آخرهم، ومن
سمعها منهم تلقاها بالقبول والتصديق لهم، ومن لم يسمعها منهم تلقاها عن التابعين كذلك وكذلك تابع التابعين مع التابعين<([24]).
ولهذا أثبتوها في مصنفاتهم وكتبهم معتقدين موجبها على ما
يليق بجلال الله تعالى، ومن نظر في كتب المحدثين الأعلام- كالبخاري ومسلم وأبي داود وأحمد وابن خزيمة-
علم يقيناً أن مذهبهم الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد.
قال ابن أبي العز: «خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له
يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر. ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع»([25]).
3- أهل السنة يؤمنون بجميع نصوص الكتاب والسنة، ويردون المتشابه إلى المحكم، والمجمل إلى المبين، ويجمعون بين نصوص الوعد والوعيد
والنفي والإثبات، والعموم
والخصوص، ويقولون بالنسخ في الأحكام
ونحو ذلك، ولا يأخذون ببعض الوحي ويردون
بعضه كشأن المرجئة الذين أخذوا بنصوص الوعد دون نصوص الوعيد، وكحال الخوارج الذين أخذوا
بنصوص الوعيد دون نصوص الوعد، وأمثالهم.
قال ابن القيم ؒ: > ذكر
أحمد الاحتجاج على إبطال قول من عارض السنن بظاهر القرآن وردها بذلك، وهذا فعل الذين يستمسكون بالمتشابه
في رد المحكم، فإن لم يجدوا لفظا متشابها
غير المحكم يردونه به استخرجوا من المحكم وصفا متشابها وردوه به، فلهم طريقان في رد السنن؛ أحدهما: ردها بالمتشابه من القرآن
أو من السنن. الثاني: جعلهم المحكم متشابها ليعطلوا
دلالته، وأما طريقة الصحابة والتابعين
وأئمة الحديث كالشافعي والإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة وأبي يوسف والبخاري وإسحاق فعكس
هذه الطريق، وهي أنهم يردون المتشابه إلى
المحكم، ويأخذون من المحكم ما يفسر
لهم المتشابه ويبينه لهم، فتتفق دلالته مع دلالة المحكم، وتوافق النصوص بعضها بعضا، ويصدق بعضها بعضا، فإنها كلها من عند الله، وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض، وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره»([26]).
4- اعتقادهم بأن الله ▐ أكمل لنا الدين، وأتم علينا النعمة ورضي لنا
الإسلام ديناً: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا» [المائدة: ٣]، وأن الرسول ♀ بلغ الدين كله أصوله وفروعه، امتثالًا لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ
رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ
النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ» [المائدة: 67]؛ قال ابن حزم: « قد
بلغ رسول الله ♀ الدين كله وبين جميعه كما أمره
الله تعالى»([27])
وقد تركنا ♥ على البيضاء
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كما قال ♀: «وَايْمُ اللَّهِ، لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ، لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا
سَوَاءٌ»([28]). قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: صَدَقَ وَاللَّهِ رَسُولُ
اللَّهِ ♀: «تَرَكَنَا وَاللَّهِ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ، لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ» ([29]).
ولذا قال الشافعي ؒ: >فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليلُ على سبيل
الهدى فيها؛ قال الله تبارك وتعالى: «كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ» [إبراهيم: 1]، وقال: «وأنزلنا إليك الذكر لتبيِّن للناس ما نُزِّل إليهم ولعلهم
يتفكرون» [النحل: 44]، وقال: «وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ
وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ» [النحل 89]، وقال: « وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي
مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ
مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * صِرَاطِ اللَّهِ
الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ
الْأُمُورُ» [الشورى: 52- 53]<([30]).
منهج الأشاعرة في التلقي:
أولًا: تقديم العقل على النقل في مسائل الاعتقاد:
قال الرازي في أساس التقديس في علم الكلام: الفصل الحادي والثلاثون في
أن البراهين العقلية إذا صارت معارضة بالظواهر النقلية فكيف يكون الحال فيها:
اعلم أن الدلائل
القطعية العقلية إذا قامت على ثبوث شيء ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك
فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة:
إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين، وهو محال.
وإما أن يبطل فيلزم تكذيب النقيضين، وهو محال.
وإما أن يصدق الظواهر النقلية ويكذب الظواهر العقلية، وذلك باطل؛ لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة
الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع وصفاته وكيفية دلالة
المعجزة على صدق الرسول ♀، وظهور المعجزات على محمد ♀، ولو جوزنا القدح في الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهما غير مقبول القول، ولو كان كذلك لخرج أن يكون
مقبول القول في هذه الأصول.
وإذا لم نثبت هذه الأصول خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة، فثبت أن القدح لتصحيح النقل
يفضي إلى القدح في العقل والنقل معا، وإنه باطل.
ولما بطلت الأقسام الأربعة لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل
العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية؛
إما أن يقال إنها غير صحيحة.
أو يقال إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها.
ثم إن جوزنا التأويل واشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات
على التفصيل، وإن لم يجز التأويل فوضنا
العلم بها إلى الله تعالى. فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابهات وبالله التوفيق([31]).
وقال الإمام الجويني ؒ: اعلموا، وفقكم الله تعالى، أن أصول العقائد تنقسم إلى:
ما يدرك عقلا، ولا يسوغ تقدير إدراكه سمعا؟
وإلى ما يدرك سمعا، ولا يتقدر إدراكه عقلا؛ وإلى ما يجوز إدراكه سمعا وعقلا.
فأما ما لا يدرك إلا عقلا فكل قاعدة في الدين تتقدم على العلم
بكلام الله تعالى ووجوب اتصافه بكونه صدقا؛ إذ السمعيات تستند إلى كلام الله تعالى؛ وما يسبق ثبوته في الترتيب
ثبوت الكلام وجوبا، فيستحيل
أن يكون مدركه السمع.
وأما ما لا يدرك إلا سمعا، فهو القضاء بوقوق ما يجوز في العقل وقوعه، ولا يجب أن يتقرر الحكم بثبوت
الجائز ثبوته فيما غاب عنا إلا بسمع. ويتصل بهذا القسم عندنا جملة أحكام التكليف، وقضاياها من التقبيح والتحسين، والإيجاب والحظر، والندب والإباحة.
وأما يجوز إدراكه عقلا وسمعا، فهو الذي تدل عليه شواهد العقول، ويتصور ثبوت العلم بكلام الله تعالى متقدما عليه. فهذا القسم يتوصل إلى دركه
بالمسع والعقل.
ونظير هذا القسم إثبات جواز الرؤية، وإثبات استبداد الباري تعالى
بالخلق والاختراع، وما
ضاهاهما مما يندرج تحت الضبط الذي ذكرناه. فأما كون الرؤية ووقوعها فطريق ثبوتها الوعد الصدق والقول
الحق.
فإذا ثبتت هذه المقدمة، فيتعين بعدها على كل معتن بالدين واثق بعقله أن ينظر فيما
تعلقت به الأدلة السمعية، فإن صادفه غير مستحيل في العقل، وكانت الأدلة السمعية قاطعة في طرقها، لا مجال للاحتمال في ثبوت أصولها ولا في تأويلها- فما هذا
سبيله فلا وجه إلا القطع به.
وإن تثبت الأدلة السمعية بطرق قاطعة، ولم يكن مضمونها مستحيلا في
العقل، وثبتت أصولها قطعا ولكن طريق
التأويل يجول فيها، فلا
سبيل إلى القطع؛ ولكن المتدين يغلب على ظنه
ثبوت ما دل الدليل السمعي على ثبوته، وإن لم يكن قاطعا، وإن كان مضمون الشرع المتصل بنا
مخالفا لقضية العقل، فهو
مردود قطعا بأن الشرع لا يخالف العقل، ولا يتصور في هذا القسم ثبوت سمع قاطع، ولا خفاء به([32]).
وقال السنوسي: >بيان أن ما أخبر الشرع به
وكان ظاهره مستحيلا عند العقل فانا نصرفه عن ظاهره المستحيل<([33]).
وقال الإيجي: >لا بد من العلم بعدم المعارض
العقلي الدال على نقيض ما دل عليه الدليل النقلي؛ إذ لو وجد ذلك المعارض لقدم على الدليل النقلي قطعا بأن يؤول
الدليل النقلي عن معناه إلى معنى آخر<([34]).
ورغم ادعاء الأشاعرة الوسطية إلاّ أنهم في هذه القضية أقرب
للمعتزلة، فكل نص بدا في ظاهره أنه يعارض
العقل وجب تأويله عندهم حتى لا يعارضه؛ لأن القاعدة الاشعرية تنص على أنه لا يمكن للنقل أن يعارض العقل البتة، لأن ذلك سيؤدي إلى إبطال العقل والنقل معا كما سبق.
لقد بنى الأشاعرة موقفهم على أن العقل هو أساس النقل، فبالعقل عرفنا ربنا، وبالعقل عرفنا صدق النبي محمد
♀، ومن هنا يجب تقديس العقل؛ لأننا إذا رددناه أمام النقل، كان ذلك نسفا للأداة التي عرفنا بها الله ▐، ومن ثم يلزم منها نسف معرفة
الله؛ فلا بد أن يبقى العقل معصومًا، حتى يلزم منه عصمة معرفة الله
▐. قد يبدو هذا البناء منطقيا، بل قد يبدو أنه لا يدعي عصمة للعقل لذات العقل؛ ولكن لأنه الوسيلة للحفاظ على النقل، متمثلا في أعز معلوماته (معرفة
الله، ومعرفة صدق رسوله ♀).
وتلك نظرية متهافتة ساقطة، فالعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح.
قال ابن تيمية ؒ: >كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه موافق لصريح المعقول، وأن العقل الصريح لا يخالف
النقل الصحيح ولكن كثيرا من الناس يغلطون إما في هذا، وإما في هذا، فمن عرف قول الرسول ومراده به كان عارفا بالأدلة الشرعية، وليس في المعقول ما يخالف
المنقول؛ ولهذا كان أئمة السنة على
ما قاله أحمد بن حنبل، قال: معرفة الحديث والفقه فيه أحب
إلي من حفظه أي "معرفته" بالتمييز بين صحيحه وسقيمه. "والفقه فيه" معرفة
مراد الرسول وتنزيله على المسائل الأصولية والفروعية أحب إلي من أن يحفظ من غير معرفة
وفقه. وهكذا قال علي بن المديني
وغيره من العلماء فإنه من احتج بلفظ ليس بثابت عن الرسول أو بلفظ ثابت عن الرسول وحمله
على ما لم يدل عليه فإنما أتي من نفسه.
وكذلك "العقليات الصريحة" إذا كانت مقدماتها وترتيبها
صحيحا لم تكن إلا حقا لا تناقض شيئا مما قاله الرسول، والقرآن قد دل على الأدلة العقلية التي بها يعرف الصانع وتوحيده
وصفاته، وصدق رسله وبها يعرف إمكان
المعاد. ففي القرآن من بيان أصول الدين
التي تعلم مقدماتها بالعقل الصريح ما لا يوجد مثله في كلام أحد من الناس بل عامة ما
يأتي به حذاق النظار من الأدلة العقلية يأتي القرآن بخلاصتها وبما هو أحسن منها قال
تعالى: «وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ
وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا» [الفرقان: 33]، وقال: «وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ
كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ
إِلَّا مُبْطِلُونَ» [الروم: 58] وقال: «وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا
إِلَّا الْعَالِمُونَ» [العنكبوت: 43] <([35]).
ثانيًا: القول بعدم حجية
خبر الآحاد في العقيدة:
قال الرازي: >أما التمسك بخبر الواحد في
معرفة الله تعالى فغير جائز يدل عليه وجوه: الأول: أن أخبار الآحاد مظنونة، فلم يجز التمسك بها في معرفة الله تعالى وصفاته، وإنما قلنا إنها مظنونة لأنا أجمعنا على أن الرواة ليسوا
معصومين... < ثم ساق أدلة منكري حجية خبر الآحاد التي ذكرها علماء أصول الفقه، ثم قال عن الصحابة في الوجه
الثاني: >إلا أنا قلنا إن الله تعالى أثنى على الصحابة ؓ
في القرآن على سبيل العموم، وذلك يفيد ظن الصدق، فلهذا الترجيح قبلنا روايتهم في فروع الشريعة، أما الكلام في ذات الله تعالى وصفاته فكيف يمكن بناؤه على
هذه الرواية الضعيفة؟ <([36])، ثم ذكر الرازي من الأسباب
الوضع في الحديث وطعن في رواة الحديث بأن الملاحدة قد يروجون عليهم بعض الأحاديث الموضوعة، كما طعن في ضبط الرواة مستشهدا
بنقلهم الحديث بالمعنى.
والأدلة التي ذكرها الرازي هي نفسها أدلة الذين لا يوجبون
العمل بخبر الآحاد في الأحكام، وما يجيبهم به الرازي في كتبه الأصولية يجاب به هنا، وكلامه عن أهل الحديث وروايتهم
كلام من ليس خبيرا بأحوالهم ومناهجهم([37]).
إلى أن قال الرازي: >واعلم أن هذا الباب كثير الكلام
وأن القدر الذي أوردناه كاف في بيان أنه لا يجوز التمسك في أصل الدين بأخبار الآحاد
والله أعلم<([38]).
وقد سبق التعرض لبعض الأدلة على حجية خبر الآحاد، وقد امتلأت كتب الأصول
بالأدلة على حجية خبر الآحاد، وأن إنكار حجية خبر في العقائد يؤدي إلى فساد عظيم.
(2) التقليد
في التوحيد.
يذهب كثير من الأشاعرة إلى أن إيمان المقلد لا يصح، وصرح بعضهم بتكفيره لأن النظر
شرط لصحة الإيمان!!
والمقلد عند الأشاعرة هو من قبل قول غيره دون أن يعرف
دليله([39])، أو هو من قبل قول الرسول ♀ دون أن يعلم حدوث العالم وإثبات وجود الله بالدليل العقلي
مثل قولهم: لا بد لكل حادث من محدث. فهذا هو النظر عند القوم، أي: النظر في الدليل العقلي.
فمن آمن بالله وبرسوله دون النظر، أي دون الاستناد إلى دليل
عقلي، فإيمانه لا يصح، بل هو من جنس الجهلة والكفرة!.
وقد رد عليهم كثير من العلماء المحققين، وبينوا وجه الصواب في المسألة، وقرروا أن هذا الرأي الفاسد
هو من كيس المعتزلة، تمسك
به كثير من متكلمي الأشعرية.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: >والعجب أن من اشترط ذلك من
أهل الكلام ينكرون التقليد، وهم أول داع إليه حتى استقر في الأذهان أن من أنكر قاعدة من القواعد التي أصلوها
فهو مبتدع ولو لم يفهمها ولم يعرف مأخذها، وهذا هو محض التقليد، فآل أمرهم إلى تكفير من قلد الرسول ♥ في معرفة الله تعالى والقول بإيمان من قلدهم، وكفى بهذا ضلالاً<([40]).
وقال بدر الدين العيني ؒ: >ومذهب أكثر المتكلمين أن إيمان المقلد في أصول الدين غير صحيح<([41]).
وقال في موضع آخر: >قالوا: فيه دليل على أن الاعتقاد
الجازم كاف في النجاة، خلافا
لمن أوجب تعلم الأدلة وجعله شرطا في الإسلام، وهو كثير من المعتزلة وقول بعض المتكلمين، وقال النووي: قد تظاهرت الأحاديث الصحيحة
التي يحصل من عمومها العلم القطعي بأن التصديق الجازم كاف<([42]).
فمسألة التقليد من المسائل المضطربة عند الأشاعرة، ولعل هذا الاضطراب ناشئ عن
خلافهم في أول واجب على العبد، فقال بعضهم: المعرفة. وقال الآخر: النظر. وقال الثالث: القصد إلى النظر. وقال الآخر: الشك.
قال صاحب (الجوهرة):
|
إذ
كل من قلّد في التوحيد |
|
إيمانه
لم يخل من ترديد? |
وفي (شرح الجوهرة) للباجوري نقل الأقوال أيضًا، ومنها: القول بالتكفير، قال: «فيكون المقلد كافرًا، وعليه السنوسي في الكبرى»([43]).
وفي شرح أم البراهين للدسوقي فقد استغرق في ذكر أقوال أئمة
المذهب بدءًا بأبي الحسن الأشعري الذي ينقل عنه أنه يرى عدم صحة إيمان المقلد، ومرورًا بالقاضي، وأبي المعالي، وابن العربي، وسائر أتباعهم ممن يطول ذِكرُه
ونَقْلُ كلامه([44]).
بينما السلف الصالح اتقفوا على أن الإنسان مفطور على الإسلام
كما بين النبي ♀: >مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا
يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ البَهِيمَةُ
بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ»، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فِطْرَةَ اللَّهِ
الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا» [الروم: 30] الآيَةَ<، فالفطرة عند السلف هي الإسلام والتوحيد.
ومعتقد أهل السنة والجماعة في المقلد في الإيمان بالله
تعالى أن إيمانه صحيح ما دام معتقدًا بصحة ما يؤمن به، ولم يجحد نصًا من كتاب أو سنة أو إجماع، والتقليد ليس على درجة
واحدة، فالتقليد منه ما هو جائز، ومنه ما ليس بجائز، ومن التقليد في العقائد([45])، قال ابن تيمية: >الناس في الاستدلال والتقليد على طرفي نقيض منهم من يوجب الاستدلال حتى في المسائل
الدقيقة: أصولها وفروعها على كل أحد. ومنهم من يحرم الاستدلال في
الدقيق على كل أحد وهذا في الأصول والفروع وخيار الأمور أوساطها<([46]).
(3) خوضهم في
صفات الله U بالتأويل
مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته: أنهم يؤمنون بها، ويثبتونها كما جاءت في القرآن
والسنة، ويمرونها كما جاءت؛ من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل، هكذا قول أهل السنة والجماعة، وهم أصحاب النبي ♀ ومن سلك سبيلهم، ولا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، ولا يكيفون ويقولون: كيفيتها كذا، كيفيتها كذا، لا، بل يمرونها كما جاءت، من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل، مثل: الرحمن، نقول: هو موصوف بالرحمة على الوجه
اللائق بالله، ليست مثل رحمة المخلوقين، ولا نعلم كيفيتها، ولا نزيد ولا ننقص، وهكذا نقول: إن الله موصوف بالاستواء: «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى» [طه: 5]، أي: ارتفع وعلا فوق العرش، فالاستواء هو العلو والارتفاع، لكن على الوجه اللائق بالله، لا يشابه استواء المخلوقين
على دوابهم، أو في سطوحهم، بل استواؤه يليق به، ويناسبه، لا يماثل صفات المخلوقين، ولا يعلم كيفيته إلا هو.
كذلك كونه يغضب، يغضب صحيح هو يغضب -جل وعلا- على من عصاه، وخالف أمره، لكن ليس مثل غضبنا، ولا نكيف ونقول: كيفيته كذا وكذا، لا، نقول: يغضب غضبًا يليق بجلاله لا
يشابه صفات المخلوقين، كما
قال سبحانه: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ» [الشورى: 11]، وقال تعالى: «وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ» [الإخلاص: 4]، وقال تعالى: «فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا» [البقرة: 22] يعني: أشباهًا ونظراء.
وهكذا نقول: له وجه، وله يد، وله قدم، وله سمع، وله بصر، لكن ليس مثل أسماعنا، ولا مثل أبصارنا، ولا مثل أيدينا، ولا مثل وجوهنا، وجه يليق بالله، يد تليق بالله، سمع يليق بالله، عين تليق بالله، لا يشابه خلقه في شيء من صفاته
ﷻ، كما قال سبحانه: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ
شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ» [الشورى: 11]، فقد أخبر عن نفسه: إنه سميع بصير، «إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» [الأنفال: 63]: «بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ» [المائدة: 64]، «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ» [ص: 75]، ويقول النبي ♀: >لاَ تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ، حَتَّى يَضَعَ رَبُّ
العِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ، فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ([47]) وَعِزَّتِكَ، وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ<([48])، وهكذا بقية الصفات نمرها كما
جاءت، مع الإيمان بها، وإثباتها لله ▐ على الوجه اللائق به ﷻ.
أما الأشاعرة فقد قسموا الصفات إلي أربعة
أقسام:
|
1-
صفات معاني. |
|
2-
الصفات المعنوية. |
|
3- الصفات
السلبية. |
|
4-
الصفة النفسية. |
1- صفات المعاني:
هي ما دل علي معنى وجودي قائم بالذات، وهي الصفات السبع: (الحياة، والعلم، والقدرة،
والإرادة، والبصر، والكلام،
والسمع).
وللأشاعرة تقسيمان آخران لصفات المعاني هما:
|
الأول: باعتبار الدليل الدال
عليها. |
|
الثاني: باعتبار التعلق. |
التقسيم الأول: صفات
المعاني من حيث الدليل الدال عليها تنقسم إلي عقليه وسمعيه.
العقليه ضابطها: لا يصح الاستدلال عليها إلا بالدليل العقلي، ولا يصح بالسمعي إلا على
وجه التأكيد، وهي: الحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة.
أما السمعية فضابطها: ما لا يصح الاستدلال عليها إلا بالدليل السمعي، وهي السمع والبصر والكلام.
التقسيم الثاني: صفات
المعاني من حيث متعلقها.
1- ما يتعلق بالممكنات فقط وهما صفتا الإرادة والقدرة، القدرة تعلقها تعلق إيجاد، والإرادة تعلقها تعلق
تخصيص.
2- ما يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات وهما صفتا
العلم والكلام.
3- ما يتعلق بالموجودات فقط، وهما صفتا السمع والبصر.
4- ما لا يتعلق بشيء وهي صفة الحياة.
والتعلق عندهم هو طلب صفات المعاني أمرًا زائدًا علي
قيامها بالذات يصلح لها.
2- الصفات المعنوية: هي
الأحكام الثابتة للموصوف بها وهي كونه حيًا، عليماً، قديرًا، مريدًا، سميعًا، بصيرًا، متكلماً.
3- الصفات السلبية: وهي
ما دل على سلب ما لا يليق بالله عن الله من غير أن يدل على معني وجودي قائم بالذات
وهي القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والوحدانية.
4- الصفة النفسية: وهي
صفة واحدة: الوجود ولا تدل على معني
زائد على الذات.
ومن هذا التقسيم يتضح أن نصيب المذهب الأشعري من الإثبات
هو سبع صفات فقط.
لأن الصفات المعنوية هي تكرار في حقيقة الأمر لصفات
المعاني السبع.
والصفة النفسية التي هي الوجود يرجعونها إلي الذات
وينفون أن تكون دالة على معني زائد على الذات.
والصفات السلبية هي صفات منفية.
فتحصَّل من ذلك إثبات سبع صفات فقط.
واحتج الأشاعرة في إثباتهم للصفات السبع بأن العقل قد
أثبت هذه الصفات ودل عليها كما يلي:
1- القدرة: دل عليها وجود المخلوقات.
2- الإرادة: دل عليها التخصيص، أي: تمييز كل شيء بما يميزه
عن غيره من الأشياء من صفة أو وقت أو مكان، فهذا التخصيص بهذه الصفات دليل على إرادة الله.
3- العلم: دل عليه الإحكام والإتقان في المخلوقات؛ فهذا لا يكون إلا بكمال العلم.
4- الحياة: القدرة والإرادة والعلم لا تقوم إلا بالحي فهي مستلزمة لا محالة للحياة، فإن الميت لا يوصف
بالقدرة والعلم والإرادة.
5، 6، 7: السمع والبصر والكلام: فلأن الحي لا يخلو من
السمع والبصر والكلام. أو
ضدها من الصمم والعمي والخرس، وهذه الأضداد نقائص؛ فوجب تنزيه الله عنها ولا سبيل لذلك إلا إثبات الضد وهو السمع والبصر والكلام.
فبهذه الدلالات العقلية أثبت الأشاعرة تلك الصفات، وأوَّلوا ما عداها من الصفات
الخبرية، كالوجه واليدين، والصفات الفعلية، كالاستواء، والنزول، والمجيء، والرضا، والغضب، والحب، والبغض، ونحوها من الصفات الخبرية
التي ذكرها الله تعالى في كتابه، أو صحت عن رسول الله ♀، فإنهم لم يؤمنوا بها كما
جاءت، وكما فعل السلف، فقد أولوها وصرفوا
ألفاظها إلى غير ظاهرها، هروبا من شبهة التجسيم والتمثيل، وزعموا أن طريقة السلف (التفويض) في هذه الصفات، وقالوا:
|
وكل
نص أوهم التشبيها |
|
فوِّضه
أو أوِّل ورمْ تنزيها |
وغفلوا عما يترتب على فعلهم هذا من تحريف لكلام الله، وتعطيل لمعانيه، والقول على الله▐ بغير علم، وغير ذلك من المستلزمات التي يقتضيها التأويل المذموم، وتنافي التسليم لله تعالى
إذ كيف يليق أن يخبر الله U
عن نفسه ويخبر عنه رسوله ♀ بصفات
لا تليق، أو تقتضي التشبيه
والتجسيم، ثم لا يكتشف هذه المسألة
إلا المتكلمون بعد القرن الثالث الهجري!
ثم كيف فات هذا الفهم على الصحابة والتابعين وسلف الأمة
ثم يدركه المتكلمون؟! هذا
مما لا يليق تجاه كلام الله ▐ وكلام رسوله ♀ والصحابة والتابعين وأئمة الهدى الأوائل ممن هم
أعلم منهم وأتقى لله، فإن
الله ▐ حين وصف نفسه بتلك الصفات: كاليدين، والوجه، والنفس، والرضا، والغضب، والمجيء، والاستواء، والعلو...... إلخ. من الصفات، فقد سد باب شبهة التمثيل
بقوله سبحانه: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ» [الشورى: 11].
فهل الذين أولوا تلك الصفات أعلم بالله من الله؟
وهل هم أشد تنزيها لله من رسوله ♀؟
وهل هم أعلم بمراد الله من صحابة رسول الله ♀ وسلف الأمة من التابعين وتابعيهم وأئمة الهدى
والسنة في القرون الفاضلة؟! الذين أَمَرُّوا هذه الصفات وغيرها من أمور الغيب كما جاءت عن الله U وعن رسوله ♀ لفظا ومعنى على مراد
الله ورسوله من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ؒ: >أهل الإثبات للصفات لهم فيما زاد على الثمانية ثلاثة أقوال معروفة:
أحدها: إثبات صفات أخرى كالرضى والغضب والوجه واليدين والاستواء، وهذا قول ابن كلاب والحارث
المحاسبي وأبي العباس القلانسي والأشعري وقدماء أصحابه كأبي عبد الله بن مجاهد وأبي
الحسن بن مهدي الطبري والقاضي أبي بكر بن الطيب وأمثالهم، وهو قول أبي بكر بن فورك وقد حكي إجماع أصحابه على إثبات
الصفات الخبرية، كالوجه واليد، وهو قول أبي القاسم القشيري
وأبي بكر البيهقي، كما
هو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل والشريف أبي علي وابن الزغوني وأبي الحسن التميمي
وأهل بيته كابنه أبي الفضل ورزق الله وغيرهم، كما هو قول سائر المنتسبين إلى أهل السنة والحديث وليس للأشعري
نفسه في إثبات صفة الوجه واليد والاستواء وتأويل نصوصها قولان، بل لم يختلف قوله أنه يثبتها
ولا يقف فيها، بل يبطل تأويلات من ينفيها، ولكن أبا المعالي وأتباعه
ينفونها، ثم لهم في التأويل والتفويض
قولان:
فأول قولي أبي المعالي التأويل كما ذكره في (الإرشاد).
وآخرهما التفويض كما ذكره في (الرسالة النظامية) وذكر إجماع
السلف على المنع من التأويل وأنه محرم.
وأما أبو الحسن وقدماء أصحابه فهم من المثبتين لها.
وقد عد القاضي أبو بكر في (التمهيد) و(الإبانة) له الصفات
القديمة خمس عشرة صفة، ويسمون
هذه الصفات الزائدة على الثمانية الصفات الخبرية، وكذلك غيرهم من أهل العلم والسنة مثل محمد بن جرير الطبري
وأمثاله، وهو قول أهل السنة والحديث
من السلف وأتباعهم وهو قول الكرامية والسالمية وغيرهم.
وهذا القول هو القول المعروف عند متكلمة الصفاتية لم يكن
يظهر بينهم غيره حتى جاء من وافق المعتزلة على نفيها، وفارق طريقة هؤلاء أنهم يثبتون الصفات السمع والعقل بخلاف
من اقتصر على الثمانية فإنه لم يثبت صفة إلا بالعقل.
وقد أثبت طائفة منهم بعضها بالعقل كما أثبت أبو أسحق الإسفراييني
صفة اليد بالعقل وكما يثبت كثير من المحققين صفة الحب والبغض والرضى والغضب بالعقل.
القول الثاني: قول من ينفي هذه الصفات كما ذكره الشهرستاني وغيره، وهو أضعف الأقوال، فإن عدته أنه لو كان لله صفة
غير لوجب أن ينصب عليها دليلاً نعلمه ولم ينصب فلا صفة له، وكلتا المقدمتين باطلة؛ فإن دعوى المدعي أنه لا بد أن ينصب الله تعالى على كل صفة
من صفاته دليلاً باطل، ودعواه
أنه لم ينصب دليلاً إلا نعلمه هو أيضاً باطل كما قد بسط الكلام على هذا في غير هذا
الموضع، فإن هذه القاعدة إنما هي معدة
لجمل المقاصد.
والثالث: قول الوافقة الذين يجوزون إثبات صفات زائدة، لكن يقولون لم يقم عندنا دليل
على نفي ذلك ولا إثباته. وهذه طريقة محققي من لم يثبت الصفات الخبرية. وهذا اختيار الرازي والأمدي وغيرهما.
وأئمة أهل السنة والحديث من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم
يثبتون الصفات الخبرية.
لكن منهم من يقول لا نثبت إلا ما في القرآن والسنة المتواترة. وما لم يقم دليل قاطع على
إثباته نفيناه كما يقوله ابن عقيل وغيره أحيانًا، ومنهم من يقول بل نثبتها بأخبار الآحاد المتلقاة بالقبول، ومنهم من يقول نثبتها بالأخبار
الصحيحة مطلقًا، ومنهم من يقول يعطى كل دليل
حقه فما كان قاطعًا في الإثبات قطعنا بموجبه، وما كان راجحًا لا قاطعًا قلنا بموجبه فلا نقطع في النفي
والإثبات إلا بدليل يوجب القطع، وإذا قام دليل يرجح لأحد الجانبين بينا رجحان أحد الجانبين وهذا أصح الطرق.
وكثير من الناس قد يظن صحة أحاديث فإما أن يتأولها أو يقول
هي مثل غيرها من الأخبار وتكون باطلة عند أئمة الحديث<([49]).
فهذا النصُّ من شيخ الإسلام ابن تيمية يبين لنا موقف المذهب
الأشعري في الصفات الزائدة على الثمانية التي يثبتونها باتفاق، وأن قدماءهم كالأشعري المؤسس
وتلاميذه وكبار أتباعه يثبتون صفات زائدة على الثمانية، وأن الاقتصار على الثمانية وتأويل أو تفويض ما سواها إنما
هو منهج بدأ على يد أبي المعالي الجويني، ومن جاء بعده، وهو
الذي استقر عليه المذهب إلى الآن.
وقال ؒ أيضاً: >إن تقديم النقل على العقل يوجب القدح فيه بالقدح في أصله، حيث تبين أن ذلك ليس قدحاً
في أصله.
وهذا الكلام في الأصل هو من قول الجهمية والمعتزلة وأمثالهم، وليس من قول الأشعري وأئمة
الصحابة وإنما تلقاه عن المعتزلة متأخرو الأشعرية لما مالوا إلى نوع التجهم، بل الفلسفة، وفارقوا قول الأشعري وأئمة
الصحابة، الذين لم يكونوا بمخالفة النقل
للعقل، بل انتصبوا لإقامة ادلة عقلية
عقلية توافق السمع.
ولهذا أثبت الأشعري الصفات الخبرية بالسمع، وأثبت بالعقل الصفات العقلية
التي تعلم بالعقل والسمع، فلم يثبت بالعقل ما جعله معارضًا للسمع، بل ما جعله معاضدًا له، وأثبت بالسمع ما عجز عنه العقل.
وهؤلاء خالفوه وخالفوا أئمة الصحابة في هذا وهذا، فلم يستدلوا بالسمع في إثبات
الصفات، وعارضوا مدلوله بما ادعوا
من العقليات<([50]).
والأصل الآخر الذي اتفق عليه أيضاً قدماؤهم ومتأخروهم نفي
الصفات الاختيارية عن اللهU، ويعبرون عنها بنفي حلول الحوادث بذات الله
U، وذلك مثل صفة الكلام، والرضى، والغضب، والفرح، والمجيء، والنزول، ونحوها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: >فلما كان من أصل ابن كلاب ومن وافقه، كالحارث المحاسبي، وأبي العباس القلانسي، وأبي الحسن الأشعري، والقضاة أبي بكر بن الطيب، وأبي يعلى بن الفراء، وأبي جعفر السماني، وأبي الوليد الباجي وغيرهم من الأعيان، كأبي المعالي الجويني وأمثاله؛ وأبي الوفاء بن عقيل، وأبي الحسن بن الزاغوني وأمثالهما: أن الرب لا يقوم به ما يكون
بمشيئته وقدرته، ويعبرون عن هذا بأنه لا تحله
الحوادث، ووافقوا في ذلك للجهم ابن
صفوان، وأتباعه من الجهمية والمعتزلة، صاروا فيما ورد في الكتاب
والسنة من صفات الرب، على
أحد قولين:
إما أن يجعلوها كلها مخلوقات منفصلة عنه. فيقولون: كلام الله مخلوق بائن عنه، لا يقوم به كلام. وكذلك رضاه، وغضبه، وفرحه، ومجيئه وإتيانه، ونزوله وغير ذلك، هو مخلوق منفصل عنه، لا يتصف الرب بشيء يقوم به
عندهم.
وإذا قالوا: هذه الأمور من صفات الفعل، فمعناه: أنها منفصلة عن الله بائنة، وهي مضافة إليه، لا أنها صفات قائمة به.
ولهذا يقول كثير منهم: إن هذه آيات الإضافات وأحاديث الإضافات، وينكرون على من يقول: آيات الصفات وأحاديث الصفات.
وإما أن يجعلوا جميع هذه المعاني قديمة أزلية، ويقولون: نزوله ومجيئه، وإتيانه وفرحه، وغضبه ورضاه، ونحو ذلك: قديم أزلي، كما يقولون: إن القرآن قديم أزلي.
ثم منهم من يجعله معنى واحدًا، ومنهم من يجعله حروفًا، أو حروفًا وأصواتًا قديمة أزلية، مع كونه مرتبًا في نفسه. ويقولون: فرق بين ترتيب وجوده، وترتيب ماهيته.
أما الصفات التي أجمع الأشاعرة على إثباتها فهي صفات المعاني
السبع: الحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام.
وأثبتوا هذه الصفات، لأن العقل دلَّ عليها دون غيرها.
قال اللقاني من الأشاعرة: >واعلم أن جملة ما تعرض له هنا من صفاته تعالى عشرون صفة، وهي ما انتهت إليه إدراكه القوى البشرية<([51]).
ولما كانت الشبهة الرئيسة للأشاعرة في نفي الصفات الاختيارية
عن الله U
هي شبهة حلول الحوادث بذات الله U، ورأوا أن العقل بزعمهم يدل على ثبوت سبع
صفات فقط، وجدوا أن هذه الصفات- ما عدا
صفة الحياة – يلزم من إثباتها حلول الحوادث
بذات الله U، فادَّعوا بأنهم وجدوا الحلَّ لهذه المعضلة
بأن قالوا بأزلية هذه الصفات، وأنها لا زمة لذات الله U
أزلاً وأبدًا، ولا يتجدد لله عند وجود هذه المخلوقات نعت ولا صفة، وإنما يتجدد مجرد التعلق بين العلم والمعلوم، وبين القدرة والمقدور، وهكذا في بقية الصفات<([52]).
وقد ابتلي المتكلمون – ومنهم الأشاعرة – بسبب التأويل في صفات الله ▐
وبعض مسائل العقيدة بأن أدخلوا في عقائدهم من المصطلحات والألفاظ والظنيات العقلية
ما لا يليق القول به في حق الباري ▐ لا نفيا
ولا إثباتا.
وأقل ما يقال فيه إنه كلام مبتدع لم يرد عن الله ولا عن
رسوله ♀ فالكف عنه أسلم، والخوض فيه قول على الله
بلا علم، مثل: الحدود والغايات، والجهات، والماهية، والحركة، والحيز، والعرض، والجوهر، والحدوث، والقدم.
ودعوى قطعية العقل وظنية النقل... ومثل كلامهم في: التركيب والتبعيض وقولهم عن الباري ▐ لا داخل العالم ولا خارجه... إلخ.
ومما ابتدعوه من الكلام عن الله تعالى نفيا وإثباتا. وذلك انسياقا مع الزامات
المعتزلة والجهمية والفلاسفة العقلية الجدلية.
وكلامهم في هذه الأمور قد يشتمل على بعض الحق أحيانا لكن
الله تعالى نهانا عنه، وأقل
ما يقال فيه أنه قول على الله بغير علم والله تعالى يقول: «وَلَا تَقْفُ
مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» [الإسراء: 36]، ويقول: «وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا
وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ» [الأعراف: 180].
(4) مسمى الإيمان عند الأشاعرة.
@@@الأشاعرة في الإيمان مرجئة جهمية وتجد في أغلب كتبهم أن
الإيمان هو التصديق القلبي.
لم تكن الأشاعرة على مقالة واحدة في مسمى الإيمان، وحتى شيخهم الأشعري مذهبه
مختلف في ذلك، وحاصل أقوالهم في هذه المسألة
ثلاثة، هي:
القول الأول: وافقوا فيه السلف في أن الإيمان قول وعمل.
وهذا هو آخر قولي الأشعري، واختاره طائفة من أصحابه
يقول شيخ الإسلام بعد ذكره قول الأشعري الذي وافق فيه الجهمية: >والقول الآخر عنه كقول السلف وأهل الحديث: إن الإيمان قول وعمل وهو اختيار طائفة من أصحابه <([53]).
قال الإمام الأشعري في (الإبانة): >قولنا الذي نقول به، وديانتنا التي ندين بها، التمسك بكتاب الله ربنا U، وبسنة نبينا محمد ♀، وما روى عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل - نضر
الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته - قائلون، ولما خالف قوله مخالفون<([54]).
ويقول شيخ الإسلام: >ولهذا لما صار يظهر لبعض أتباع
أبي الحسن فساد قول جهم في الإيمان خالفه كثير منهم؛ فمنهم من اتبع السلف.
قال أبو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني في (شرح الإرشاد)
لأبي المعالي بعد أن ذكر قول أصحابه قال: وذهب أهل الأثر إلى أن الإيمان جميع الطاعات فرضها ونفلها، وعبروا عنه بأنه إتيان ما
أمر الله به فرضا ونفلا، والانتهاء عما نهى عنه تحريما وأدبا. قال: وبهذا كان يقول أبو علي الثقفي من متقدمي أصحابنا؛ وأبو العباس القلانسي. وقد مال إلى هذا المذهب أبو عبد الله بن مجاهد قال: وهذا قول مالك بن أنس إمام
دار الهجرة، ومعظم أئمة السلف رضوان الله
عليهم أجمعين. وكانوا يقولون: الإيمان معرفة بالقلب وإقرار
باللسان وعمل بالأركان<([55]).
@@@القول الثاني: وافقوا فيه فقهاء المرجئة، وابن كلاب، في أن الإيمان تصديق القلب، وقول اللسان.
فقد ذكر شيخ الإسلام أنه لما ظهر لبعض أتباع أبي الحسن فساد
قول جهم في الإيمان خالفوا إمامهم، وقالوا بقول المرجئة: إن التصديق بالقلب وقول اللسان.
ويقول أبو القاسم الأنصاري الأشعري في حكاية مذاهب أصحابه:
>وهل يشترط في الإيمان الإقرار؟
اختلفوا فيه بعد أن لم يختلفوا في أن ترك العناد شرط وهو
أن يعتقد أنه متى طولب بالإقرار فأتى به أما قبل أن يطالب به، منهم من قال لا بد من الإتيان
به حتى يكون مؤمنا، وهذا
القائل يقول التصديق هو المعرفة والإقرار جميعا.
وهذا قول الحسين بن الفضل البجلي وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه
ويقرب من هذا ما كان يقوله الإمام أبو محمد عبد الله بن سعيد القطان من متقدمي أصحابنا<([56]).
ويقول شيخ الإسلام: >وابن كلاب - نفسه - والحسين
بن الفضل البجلي ونحوهما كانوا يقولون: هو التصديق والقول جميعا موافقة لمن قاله من فقهاء الكوفيين كحماد بن أبي سليمان
ومن اتبعه مثل أبي حنيفة وغيره<([57]).
القول الثالث: وافقوا فيه الجهمية في أن الإيمان مجرد تصديق القلب.
قال شيخ الإسلام ؒ: >وأما الأشعري: فالمعروف
عنه، وعن أصحابه: أنّهم يُوافقون جهماً في قوله
في الإيمان، وأنّه مجرّد تصديق القلب، أو معرفة القلب<([58]). "
ويقول: >وبهذا وغيره يتبين فساد قول جهم والصالحي ومن اتبعهما في
"الإيمان"، كالأشعري في أشهر قوليه وأكثر أصحابه وطائفة من متأخري أصحاب
أبي حنيفة، كالماتريدي ونحوه
حيث جعلوه مجرد تصديق في القلب يتساوى فيه العباد وأنه إما أن يعدم، وإما أن يوجد لا
يتبعض، وأنه يمكن وجود الإيمان
تاما في القلب مع وجود التكلم بالكفر والسب لله ورسوله طوعا من غير إكراه، وأن ما علم من الأقوال
الظاهرة أن صاحبه كافر؛ فلأن ذلك مستلزم عدم ذلك التصديق الذي في القلب، في الأفعال..... وأن الأعمال الصالحة
الظاهرة ليست لازمة للإيمان الباطن الذي في القلب؛ بل يوجد إيمان القلب
تاما بدونها فإن هذا القول فيه خطأ من وجوه:
أحدها: أنهم أخرجوا ما في القلوب من حب لله وخشيته ونحو ذلك أن يكون
من نفس الإيمان.
وثانيها: جعلوا ما علم أن صاحبه كافر - مثل إبليس وفرعون واليهود وأبي
طالب وغيرهم - أنه إنما كان كافرا؛ لأن ذلك مستلزم لعدم تصديقه في الباطن وهذا مكابرة للعقل
والحس، وكذلك جعلوا من يبغض
الرسول ويحسده كراهة دينه مستلزما لعدم العلم بأنه صادق ونحو ذلك.
و(ثالثها): أنهم جعلوا ما يوجد من التكلم بالكفر من سب الله ورسوله، والتثليث وغير ذلك
قد يكون مجامعا لحقيقة الإيمان الذي في القلب، ويكون صاحب ذلك مؤمنا
عند الله حقيقة سعيدا في الدار الآخرة، وهذا يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام.
و(رابعها): أنهم جعلوا من لا يتكلم بالإيمان قط مع قدرته على ذلك ولا
أطاع الله طاعة ظاهرة مع وجوب ذلك عليه وقدرته يكون مؤمنا بالله تام الإيمان سعيدا
في الدار الآخرة. وهذه الفضائح تختص بها الجهمية دون المرجئة من الفقهاء وغيرهم.
و(خامسها): وهو يلزمهم ويلزم المرجئة أنهم قالوا: إن العبد قد يكون
مؤمنا تام الإيمان إيمانه مثل إيمان الأنبياء والصديقين ولو لم يعمل خيرا لا صلاة ولا
صلة ولا صدق حديث ولم يدع كبيرة إلا ركبها فيكون الرجل عندهم إذا حدث كذب وإذا وعد
أخلف وإذا اؤتمن خان وهو مصر على دوام الكذب والخيانة ونقض العهود لا يسجد لله سجدة، ولا يحسن إلى أحد
حسنة، ولا يؤدي أمانة ولا
يدع ما يقدر عليه من كذب وظلم وفاحشة إلا فعلها وهو مع ذلك مؤمن تام الإيمان، إيمانه مثل إيمان
الأنبياء، وهذا يلزم كل من
لم يقل إن الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان الباطن فإذا قال: إنها من لوازمه وأن
الإيمان الباطن يستلزم عملا صالحا ظاهرا كان بعد ذلك، قوله: إن تلك الأعمال لازمة
لمسمى الإيمان أو جزء منه (نزاعا لفظيا كما تقدم).
و(سادسها): أنه يلزمهم أن من سجد للصليب والأوثان طوعا وألقى المصحف
في الحش عمدا، وقتل النفس بغير
حق وقتل كل من رآه يصلي وسفك دم كل من يراه يحج البيت؛ وفعل ما فعلته القرامطة
بالمسلمين يجوز أن يكون مع ذلك مؤمنا وليا لله، إيمانه مثل إيمان
النبيين والصديقين؛ لأن الإيمان الباطن إما أن يكون منافيا لهذه الأمور وإما
ألا يكون منافيا؛ فإن لم يكن منافيا أمكن وجودها معه فلا يكون وجودها إلا مع
عدم الإيمان الباطن. وإن كان منافيا للإيمان الباطن كان ترك هذه من موجب الإيمان
ومقتضاه ولازمه فلا يكون مؤمنا في الباطن الإيمان الواجب إلا من ترك هذه الأمور فمن
لم يتركها دل ذلك على فساد إيمانه الباطن وإذا كانت الأعمال والتروك الظاهرة لازمة
للإيمان الباطن كانت من موجبه ومقتضاه وكان من المعلوم أنها تقوى بقوته وتزيد بزيادته
وتنقص بنقصانه فإن الشيء المعلول لا يزيد إلا بزيادة موجبه ومقتضيه ولا ينقص إلا بنقصان
ذلك؛ فإذا جعل العمل الظاهر
موجب الباطن ومقتضاه لزم أن تكون زيادته لزيادة الباطن فيكون دليلا على زيادة الإيمان
الباطن ونقصه لنقص الباطن فيكون نقصه دليلا على نقص الباطن وهو المطلوب. وهذه الأمور كلها
إذا تدبرها المؤمن بعقله تبين له أن مذهب السلف هو المذهب الحق؛ الذي لا عدول عنه؛ وأن من خالفهم لزمه
فساد معلوم بصريح المعقول وصحيح المنقول كسائر ما يلزم الأقوال المخالفة لأقوال السلف
والأئمة والله أعلم<([59]).
ويقول شيخ الإسلام: >وأما جهم فكان يقول: إن الإيمان مجرد تصديق القلب
وإن لم يتكلم به وهذا القول لا يعرف عن أحد من علماء الأمة وأئمتها؛ بل أحمد ووكيع وغيرهما كفروا
من قال بهذا القول ولكن هو الذي نصره الأشعري وأكثر أصحابه؛ ولكن قالوا مع ذلك إن كل من
حكم الشرع بكفره حكمنا بكفره واستدللنا بتكفير الشارع له على خلو قلبه من المعرفة<([60]).
ويقول: >فهؤلاء القائلون بقول جهم
والصالحي قد صرحوا بأن سب الله ورسوله؛ والتكلم بالتثليث وكل كلمة من كلام الكفر ليس هو كفرا في الباطن ولكنه دليل
في الظاهر على الكفر ويجوز مع هذا أن يكون هذا الساب الشاتم في الباطن عارفا بالله
موحدا له مؤمنا به.
فإذا أقيمت عليهم حجة بنص أو إجماع أن هذا كافر باطنا وظاهرا. قالوا: هذا يقتضي أن ذلك مستلزم للتكذيب
الباطن، وأن الإيمان يستلزم عدم ذلك؛ فيقال لهم: معنا أمران معلومان. (أحدهما): معلوم بالاضطرار من الدين. و(الثاني) معلوم بالاضطرار
من أنفسنا عند التأمل. أما
"الأول": فإنا
نعلم أن من سب الله ورسوله طوعا بغير كره، بل من تكلم بكلمات الكفر طائعا غير مكره ومن استهزأ بالله
وآياته ورسوله فهو كافر باطنا وظاهرا وأن من قال: إن مثل هذا قد يكون
في الباطن مؤمنا بالله وإنما هو كافر في الظاهر فإنه قال قولا معلوم الفساد بالضرورة
من الدين. وقد ذكر الله كلمات
الكفار في القرآن وحكم بكفرهم واستحقاقهم الوعيد بها ولو كانت أقوالهم الكفرية بمنزلة
شهادة الشهود عليهم أو بمنزلة الإقرار الذي يغلط فيه المقر لم يجعلهم الله من أهل الوعيد
بالشهادة التي قد تكون صدقا وقد تكون كذبا بل كان ينبغي أن لا يعذبهم إلا بشرط صدق
الشهادة وهذا كقوله تعالى: «لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ
قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ» [المائدة: 73]، «لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ
بْنُ مَرْيَمَ» [المائدة: 17]، وأمثال ذلك.
وأما " الثاني ": فالقلب إذا كان معتقدا
صدق الرسول وأنه رسول الله، وكان محبا لرسول الله معظما له امتنع مع هذا أن يلعنه ويسبه، فلا يتصور ذلك منه
إلا مع نوع من الاستخفاف به وبحرمته؛ فعلم بذلك أن مجرد اعتقاد أنه صادق لا يكون إيمانا إلا مع
محبته وتعظيمه بالقلب<([61]).
والخلاصة أن الأشاعرة >ذهبوا مذهب الجهمية الأولى في أن
الإيمان هو مجرد التصديق الذي في القلب وإن لم يقترن به قول اللسان ولم يقتض عملا في
القلب ولا في الجوارح وصرح القاضي أبو يعلى بذلك<([62]).
وقد نقل شيخ الإسلام كلام
عدد من علماء الأشاعرة حول مذهبهم في الإيمان، وأكثر من النقل عن
أبي القاسم الأنصاري >شيخ الشهرستاني في (شرح الإرشاد) بعد أن ذكر شرح قول الخوارج
والمعتزلة والكرامية، قال: وأما مذاهب أصحابنا فصار أهل التحقيق من أصحاب الحديث والنظار
منهم إلى أن الإيمان هو التصديق وبه قال شيخنا أبو الحسن واختلف جوابه في معنى التصديق
فقال مرة هو المعرفة بوجوده وقدمه وإلهيته. وقال مرة التصديق قول في النفس
غير أنه يتضمن المعرفة ولا يوجد دونها، وهذا مما ارتضاه القاضي فإن الصدق والكذب والتصديق والتكذيب بالأقوال أجدر؛ فالتصديق إذا قول في النفس
ويعبر عنه باللسان، فتوصف
العبارة بأنها تصديق؛ لأنها
عبارة عن التصديق هذا ما حكاه شيخنا الإمام.
قلت: فقد ذكر عن أبي الحسن الأشعري قولين:
أحدهما: إن التصديق هو المعرفة وهذا قول جهم.
والثاني: إن التصديق قول في النفس يتضمن المعرفة وهو اختيار ابن الباقلاني وابن الجويني
وهؤلاء قد صرحوا بأنه يتضمن المعرفة ولا ينتصر أن يقوم في النفس تصديق مخالف لمعرفة
كما ذكروه، ولو جاز أن يصدق بنفسه بخلاف
علمه واعتقاده لانتقض أصلهم في الإيمان إذا كان التصديق لا ينافي اعتقاد خلاف ما صدق
به فلا يجب أن يكون مؤمنا بمجرد تصديق النفس على هذا التقدير وكل من القولين ينقض ما
استدل به على أن التصديق غير العلم<([63]).
ثم قال شيخ الإسلام ؒ: >ومن جعل الإيمان هو تصديق القلب يقول: كل كافر في النار ليس معهم من التصديق بالله شيء، لا مع إبليس ولا مع غيره. وقد قال الله تعالى: «وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ
لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ
عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ» [غافر: 48]. وقال تعالى: «وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى
إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ
رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ
يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ» [الزمر: 71]، فقد اعترفوا بأن الرسل أتتهم
وتلت عليهم آيات ربهم وأنذرتهم لقاء يومهم هذا؛ فقد عرفوا الله ورسوله واليوم الآخر وهم في الآخرة كفار..... فإن قالوا: الإيمان في الآخرة لا ينفع
وإنما الثواب على الإيمان في الدنيا. قيل: هذا صحيح لكن إذا لم يكن الإيمان
إلا مجرد العلم؛ فهذه الحقيقة لا تختلف فإن
لم يكن العمل من الإيمان فالعارف في الآخرة لم يفته شيء من الإيمان. لكن أكثر ما يدعونه أنه حين
مات لم يكن في قلبه من التصديق بالرب شيء. ونصوص القرآن في غير موضع تدل على أن الكفار كانوا في الدنيا
مصدقين بالرب حتى فرعون الذي أظهر التكذيب كان في باطنه مصدقا. قال تعالى: «وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا
وَعُلُوًّا»<([64]).
(5) مخالفتهم
لأهل السنة في القرآن وإثباتهم للكلام النفسي وعد إثباتهم للحرف والصوت.
أولًا: عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن:
قال الطحاوي ؒ: >وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده
بسقر حيث قال تعالى: «سَأُصْلِيهِ سَقَرَ» [المدثر: 26]، فلما أوعد الله بسقر لمن قال: «إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ»[المدثر: 25] علمنا وأيقنا أنه قول
خالق البشر، ولا يشبه قول البشر<([65]).
فمن الصفات التي أثبتها الله ﷻ
لنفسه وأثبتها له رسوله ♀ صفة الكلام له سبحانه
وتعالى، ومن الأدلة على ذلك:
قوله تعالى: «وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا» [النساء: 87]، وقوله تعالى: «وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا» [النساء: 122].
وجه الدلالة في الآيتين في لفظ (حديثا)، (قيلا) وهما تمييز لكلمة أصدق، والأسلوب أسلوب استفهام، ومن اسم استفهام بمعنى النفي، وإتيان النفي بصيغة الاستفهام
أبلغ من إتيان النفي مجردا؛ لأنه يكون فيه معنى التحدي؛ كأنه يقول: لا
أحد أصدق من الله حديثا، وإذا كنت تزعم خلاف ذلك فمن يكون؟!.
وقوله تعالى: «وَإِذْ قَالَ
اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ
إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ» [المائدة: 116].
وجه الشاهد أن (يا عيسى بن مريم) جملة في محل نصب مقول القول؛ فالقائم بفعل القول هو الله
تعالى، وقد قال: (يا عيسى ابن مريم.... ) فلزم من ذلك إثبات أن الله
تعالى يقول، وأن قوله مسموعا؛ أي كلامه سبحانه وتعالى بصوت، وأن قوله كلام وجمل فيكون
بحرف، ولهذا كانت عقيدة أهل السنة
والجماعة أن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي متى شاء وكيف شاء بما شاء (بحرف وصوت ولفظ
ومعنى) بكيفية تليق به ▐، لا يشبهه أحد من خلقه، ولا يشبه أحدا من خلقه سبحانه
وتعالى. (متى شاء) باعتبار الزمن، (كيف شاء) يعني على الكيفية
والصفة التي تليق به ▐، (بما شاء) باعتبار الكلام؛ يعني موضوع الكلام من أمر أو نهي أو غير ذلك، (بحرف و صوت) لأن (يا عيسى
ابن مريم... ) هكذا بحروف وبصوت؛ لأن عيسى عليه السلام سمع
ما قال، (بلفظ ومعنى) لأن هذه العبارة
مكونة من ألفاظ، ولها معنى فهمه عيسى فرد بما
يناسب هذا الكلام وبين أن ما نسب إليه من أنه طلب من قومه عبادته وأمه لم يكن صحيحا، (لا يماثل أصوات المخلوقين)
لأنه سبحانه وتعالى قال: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ
شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ»} [الشورى: 11]، ولأنه سبحانه عظيم القدر، وصفة العظيم تليق به سبحانه؛ لأن الصفة على قدر الموصوف، وطالما أننا لا نعلم كيفية
ذات الله، فلا مجال للعلم بكيفية صفاته؛ لأن الكلام في الصفات فرع
عن الكلام في الذات، وكما
أن صفة المخلوق على قدره، فصفة الخالق تليق بكماله وجلاله، وكل ما تتخيله فالله أعظم منه، ولا يحيط بصفة الله ▐ إلا هو ﷻ ([66]).
ثانيًا: اعتقاد الأشاعرة في القرآن الكريم وفي كلام الله تعالى.
يلاحظ أن مذهب الأشاعرة في كلام الله تعالى يقوم على عدة
أمور - بعد إثباتهم لصفة الكلام بإجمال ضمن الصفات السبع - فهم يقولون:
1- إنه معنى قائم بالنفس، دون الحروف والألفاظ. وهذا ما يسمونه بالكلام النفسي، ومن ثم منعوا أن يكون كلام الله بحرف وصوت.
2- وإنه قديم أزلي قائم بذات الله تعالى كحياته وعلمه، ولذا فهو لا يتعلق بمشيئة
الله وقدرته، ولا يتكلم إذا شاء متى شاء.
3- وإنه معنى واحد لا يتجزأ، هو الأمر بكل مأمور والنهي عن كل منهي عنه، والخبر عن كل مخبر عنه، إن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً.
4- إن القرآن العربي عبارة عن كلام الله، إن القرآن العربي عبارة عن كلام الله، وهو مخلوق، أتى به جبريل أو محمد ♀، أو أوجده الله في الهواء أو في اللوح المحفوظ. ودعموا مذهبهم هذا بمذهب اللفظية الذين قالوا: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ولما كان الإمام أحمد وهو
إمام أهل السنة قد أنكر على الطائفتين وبدعهم: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق، ومن قال لفظي به غير مخلوق، لما في ذلك من اللبس وخلط الحق بالباطل - قالت الأشعرية: إن الإمام قصد باللفظ: النبذ والطرح، ولم يقصد التلاوة، وإنه قصد إنكار هذا المعنى
على من قال: لفظي بالقرآن مخلوق([67]).
5- إن تكليم الله لملائكته وتكليمه لموسى، وتكليمه لعباده يوم القيامة، ومناداته لمن ناداه، إنما هو خلق إدراك في المستمع
أدرك به ما لم يزل موجوداً([68]).
فالقرآنُ عندهم والتَّوراةُ والِإنجيلُ بألفاظِها وحُروفها
مخلوقةٌ، وهي دَلالاتٌ على الكلام النَّفسيّ، خلَقَها الله في شَيْءٍ.
قالوا في القرآن العربيّ: خلَقَه الله في اللَّوْح المَحفوظ -وهذا أشهَرُ عند متأخِّريهم، وهو الذي يقولُه صاحب
"تحفة المريد" وغيره-.
ومنهم مَن قال: خلَقَهُ في الهَواء، فأخَذَهُ جبريلُ ♠.
ومنهم مَن قال: بلْ إنَّ الله أفْهَمَ جبريلَ المعنى، فعبَّرَ عنه جبريلُ بقولِهِ، فالقرآن قولُ جبريلَ♠
وهذا صرَّحَ به أكبرُ مُحقِّقيهم على الإِطلاق بعدَ الأشعري: أبو بكر الباقلّاني.
ومنهم مَن قال: بل هو عبارةُ محمَّد ♀ وهو قولٌ مرجوحٌ عند
متأخِّريهم، لكنه مذكورٌ مشهورٌ عندهم ([69]).
رد شارح الطحاوية عليهم:
قال ابن أبي العز الحنفي: >وفي قوله: بالحقيقة رد على من قال: إنه معنى واحد قام بذات الله
لم يسمع منه، وإنما هو الكلام النفساني؛ لأنه لا يقال لمن قام به الكلام
النفساني ولم يتكلم به: أن هذا كلام حقيقة، وإلا للزم أن يكون الأخرس متكلما، ولزم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله، ولكن عبارة عنه ليست هي كلام
الله، كما لو أشار أخرس إلى شخص
بإشارة فهم بها مقصوده، فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس، فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص
عن ذلك المعنى. وهذا المثل مطابق غاية المطابقة
لما يقولونه، وإن كان الله تعالى لا يسميه
أحد أخرس، لكن عندهم أن الملك فهم منه
معنى قائما بنفسه، لم
يسمع منه حرفا ولا صوتا، بل فهم معنى مجردا، ثم عبر عنه، فهو
الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي، أو أن الله خلق في بعض الأجسام كالهوى الذي هو دون الملك هذه العبارة.
ويقال لمن قال إنه معنى واحد: هل سمع موسى ♠ جميع المعنى
أو بعضه؟ فإن قال: سمعه كله، فقد زعم أنه سمع جميع كلام
الله ▐ وفساد هذا ظاهر. وإن قال: بعضه، فقد قال يتبعض. وكذلك كل من كلمه الله أو
أنزل إليه شيئا من كلامه.
ولمَّا قال تعالى للملائكة: «إِنِّي جَاعِلٌ
فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» [البقرة: 30]. ولمَّا قال لهم: «اسْجُدُوا لِآدَمَ» [البقرة: 34]. وأمثال ذلك: هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ فإن قال: إنه جميعه، فهذا مكابرة، وإن قال: بعضه، فقد اعترف بتعدده<([70]).
(6) القضاء
والقدر بين أهل السنة والأشاعرة.
مراتب الإيمان بالقضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة:
يؤمن أهل السنة والجماعة بأن الله علم ما كان وما يكون
وما لم يكن كيف كان يكون، وأنه كتب في اللوح المحفوظ بعلمه ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، ثم تبعت تلك الكتابة
كتابات، وأن للعبد مشيئة وإرادة
حقيقية إلا أنها لا تخرج عن مشيئة الله U وإرادته الكونية «لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ * وَمَا تَشَاءُونَ
إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ» [التكوير: 28- 29]، وأن العبد فاعل منفعل، فالعبد فاعل لفعله حقيقة، والعبد وفعله من خلق الله
تعالى، ومدار فهم القضية على فهم
الفرق بين المعنى والكيف في صفات الله ▐؛ فالمعنى يدرك من خلال
الألفاظ، والكيف لا يعلمه إلا الله
▐، ونحن وإن كنا ندرك كيفية فعل العبد، فأنى لنا أن ندرك كنه صفات الله تعالى وأفعاله، ولتيسير فهم الأمر فإن
الطفل مولود لأبويه، والطفل
وأبويه من خلق الله تعالى، فكذلك فعل العبد، العبد فاعل له حقيقة كما الطفل مولود لأبويه لأنهما من باشر السبب بالزواج، والعبد وفعله مخلوق لله
كما الطفل وأبويه من خلق الله.
القضاء والقدر عند الأشاعرة:
أفعال العباد - وهو أصل الخلاف في القدر - اتفقت الأشاعرة
مع أهل السنة في وجه وخالفتهم في وجه آخر، إذ إن أفعال العباد لها متعلقان - بالله وبالعبد -:
الأول: بالله، فهذا القدر هو القدر المتفق
بين أهل السنة والاشاعرة على أن الله خالق أفعال العباد.
الثاني: بالعبد، وهنا وقع الخلاف بين أهل السنة
والأشاعرة، من حيث إثبات تأثير قدرة العبد
على الأفعال.
فالأشاعرة تتفق مع أهل السنة في إثبات القدر، وأن الله خالق أفعال العباد.
أما قولهم بإثبات قدرة للعبد غير مؤثرة، وتسمية فعله كسبا، فشيخ الإسلام يرجع أصل قولهم
هنا إلى قضية سبق شرحها في باب الصفات وهي قولهم: إن الفعل هو المفعول، والخلق هو المخلوق، وعدم تفريقهم بين ما يقوم بالله من الأفعال، وما هو منفصل عنه، وجعلهم كل أفعال الله مفعولة
له منفصلة عنه.
فلما جاءوا إلى مسألة القدر وأفعال العباد واعتقدوا أنها
مفعولة لله، قالوا: هي فعله، لأن الفعل عندهم هو المفعول، فيقيل لهم في ذلك: أهي فعل العبد؟ فاضطربوا في الإجابة، وانقسموا حيالها إلى أقوال
ثلاثة:
فهم بنوا نظريتهم في الكسب وقدرة العبد على أصول غير مسلمة، وهي:
أولاً: الفعل هو المفعول.
والأشاعرة أطردت أصلاً فاسداً في توحيد الأسماء والصفات، أثرت على هذه المسألة، إذ جعلوا الفعل هو المفعول، ويظهر تأثير هذا الأصل في
مسألة أفعال العباد عند إيراد هذا السؤال عليهم: هل أفعال العباد فعل العبد؟ وقد تخبطوا في الإجابة، وانقسموا إلى ثلاثة أقوال:
جمهورهم قالوا: هي كسب العبد لا فعله، ولم يفرقوا بين الكسب والفعل بفرق محقق.
ومنهم من قال: بل هي فعل بين فاعلين، وهو قول الغزالي.
ومنهم من قال: بل الرب فعل ذات الفعل والعبد صفته، وهذا قول الباقلاني([71]).
ثال شيخ الإسلام ابن تيمية ؒ: >والتحقيق ما عليه أئمة السنة وجمهور الأمة؛ من الفرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق؛ فأفعال العباد هي كغيرها من
المحدثات مخلوقة مفعولة لله، كما أن نفس العبد وسائر صفاته مخلوقة مفعولة لله، وليس ذلك نفس خلقه وفعله بل هي مخلوقة ومفعولة، وهذه الأفعال هي فعل العبد
القائم به ليست قائمة بالله ولا يتصف بها فإنه لا يتصف بمخلوقاته ومفعولاته؛ وإنما يتصف بخلقه وفعله كما
يتصف بسائر ما يقوم بذاته، والعبد فاعل لهذه الأفعال، وهو المتصف بها وله عليها قدرة، وهو فاعلها باختياره ومشيئته، وذلك كله مخلوق لله، فهي فعل العبد ومفعولة للرب. لكن هذه الصفات: لم يخلقها الله بتوسط قدرة العبد ومشيئته؛ بخلاف أفعاله الاختيارية؛ فإنه خلقها بتوسط خلقه لمشيئة العبد وقدرته كما خلق غير ذلك؛ من المسببات بواسطة أسباب
أخر<([72]).
وبهذا التفصيل الجيد يتبين غلط الأشاعرة حين جعلوا الفعل
هو المفعول، فأوقعهم هذا في مأزق الكسب
الذي اشتهروا به ولم يستطيعوا التخلص منه.
ومع هذا الرد المجمل فإن لشيخ الإسلام كثيراً من الردود التفصيلية، وأهمها:
1- كسب الأشعري لا حقيقة له، لأنهم فسروه بأنه عبارة عن اقتران المقدور بالقدرة الحادثة، وقالوا: الخلق هو المقدور بالقدرة
القديمة. وما دام العبد ليس بفاعل، ولا له قدرة مؤثرة في الفعل
فالزعم بأنه كاسب، وتسمية
فعله كسبا لا حقيقة له؛ لأنه القائل بذلك لا يستطيع أن يوجد فرقا بين الفعل الذي نفاه عن العبد، والكسب الذي أثبته له([73]).
وكثيرا ما يشير شيخ الإسلام إلى أن قول الأشاعرة هذا قريب
من قول الجهم الذي يصرح بالجبر([74]).
2- أما زعمهم بأنهم يفرقون بين الكسب الذي أثبتوه وبين الخلق؛ بأن الكسب: عبارة عن اقتران المقدور بالقدرة
الحادثة، والخلق هو المقدور بالقدرة
القديمة، وقولهم أيضاً: الكسب هو الفعل القائم بمحل
القدرة عليه، والخلق هو الفعل الخارج عن
محل القدرة عليه، وزعمهم
أن هذا يبعد قولهم عن قول الجهم الذي يقول بالجبر المحض([75])، أما مزاعمهم هذه فمردودة بما
يلي:
(أ) أن قولهم هذا >لا يوجب فرقاً بين كون العبد كسب، وبين كونه فعل، وأوجد، وأحدث، وصنع، وعمل، ونحو ذلك، فإن فعله وإحداثه وعمله وصنعه
هو أيضاً مقدور بالقدرة الحادثة، وهو قائم في محل القدرة الحادثة<([76]).
(ب) >وأيضا فهذا فرق لا حقيقة له فإن كون المقدور في محل القدرة أو خارجا عن محلها
لا يعود إلى نفس تأثير القدرة فيه: وهو مبني على أصلين: أن الله لا يقدر على فعل يقوم بنفسه، وأن خلقه للعالم هو نفس العالم. وأكثر العقلاء من المسلمين وغيرهم على خلاف ذلك.
والثاني: أن قدرة العبد لا يكون مقدورها إلا في محل وجودها، ولا يكون شيء من مقدورها خارجا عن محلها. وفي ذلك نزاع طويل ليس هذا
موضعه.
وأيضا فإذا فسر التأثير بمجرد الاقتران فلا فرق بين أن يكون
الفارق في المحل أو خارجا عن المحل.
وأيضا قال لهم المنازعون: من المستقر في فطر الناس أن من فعل العدل فهو عادل، ومن فعل الظلم فهو ظالم، ومن فعل الكذب فهو كاذب، فإذا لم يكن العبد فاعلا لكذبه
وظلمه وعدله، بل الله فاعل ذلك لزم أن يكون
هو المتصف بالكذب والظلم.
قالوا: وهذا كما قلتم أنتم وسائر الصفاتية: من المستقر في فطر الناس أن من قام به العلم فهو عالم، ومن قامت به القدرة فهو قادر، ومن قامت به الحركة فهو متحرك، ومن قام به التكلم فهو متكلم، ومن قامت به الإرادة فهو مريد، وقلتم إذا كان الكلام مخلوقا
كان كلاما للمحل الذي خلقه فيه كسائر الصفات، فهذه القاعدة المطردة فيمن قامت به الصفات نظيرها أيضا من
فعل الأفعال. وقالوا أيضا: القرآن مملوء بذكر إضافة هذه
الأفعال إلى العباد كقوله تعالى: «جَزَاءً بِمَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ» [السجدة: 17]، وقوله: «اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» [فصلت: 40] وقوله: «وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ» [التوبة: 105] وقوله: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» [البقرة: 277] وأمثال ذلك<([77]).
فالأشاعرة بنوا أقوالهم في الكسب وقدرة العبد على أصول غير
مسلمة. وأن الشرع والعقل متفقان على
أن العبد يحمد ويذم على فعله، ويكون حسنة له أو سيئة، فلو لم يكن إلا فعل غيره لكان ذلك الغير هو المحمود المذموم عليها([78]).
ومن الأمور التي ينبغي الإشارة إليها: معنى الكسب عند أهل السنة، فكثيراً ما يذكر علماء السنة
أن أفعال العباد كسب لهم، وقد يقع إيهام في ذلك خاصة، وإن الأشاعرة يعبرون عن مذهبهم في هذا الموضوع بالكسب، فيقع الإيهام أحياناً، ونوضح هنا أن أهل السنة عندما
يقولون: إن أفعال العباد كسب لهم، معناه: أنها أفعالهم التي تعود على
فاعليها بنفع أو ضر، ما
قال تعالى: «لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ» [البقرة: 286]، فبين سبحانه أن كسب النفس
لها أو عليها، ولما كان العباد يَكْمُلُون
بأفعالهم ويصلحون بها، إذ
كانوا في أول الخلق خلقوا ناقصين، صح إثبات السبب، إذ كمالهم وصلاحهم من أفعالهم". فمقصود أهل السنة أنها كسب لهم واقعة بقدرتهم وإرادتهم وكل
أفعالهم مخلوقة لله ▐([79]).
(6) إثبات وجود
الله.
فمذهب السلف هو أن وجوده تعالى أمر فطري معلوم بالضرورة، والأدلة عليه في الكون والنفس
والآثار والآفاق والوحي أجل من الحصر، ففي كل شيء له آية وعليه دليل؛ أما الأشاعرة فعندهم دليل يتيم هو دليل: الحدوث والقدم.
(7) التوحيد>
والتوحيد عند أهل السنة والجماعة معروف بأقسامه الثلاثة، وهو عندهم أول واجب على المكلف.
أما الأشاعرة -قدماؤهم ومعاصروهم- فالتوحيد عندهم هو نفي
التثنية أو التعدد، ونفي
التبعيض والتركيب والتجزئة.
هذا الذي ذكرته بعض ما فارق فيه الأشاعرة منهج أهل السنة
والجماعة، فضلا عن صعوبة فهم الكثير
من أدلة الأشاعرة كعادة أهل الكلام، مما يجعل أمر العقيدة أمرا معقدًا لا اعتقادًا، ألفاظًا تقسو معها القلوب، جعلت الكثير ممن نهج منهج علم الكلام يرجع عن كلامه في
آخر حياته لقر بصحة عقيدة العقائد، إذ استدلال القرآن والسنة الذي فهمه عامة الخلق من المؤمنين غاب عن كثير من
المتكلمين فلم يفهموا أنهم انتهجوا غيره إلا بعد لأي وجهد، ويكفي القارئ الكريم أن ينظر إلى طريقة القرآن في إثبات توحيد الربوبية،
وطريقة الأشاعرة في العرض والجوهر، والجوهر الفرد وحلول الحوادث وغير ذلك.
فالقرآن أثبت الربوبية بالحجة الدامغة:
قال الله تبارك وتعالى في مقام إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية
«أَمْ خُلِقُوا مِنْ
غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الخَالِقُونَ * أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ
بَل لاَّ يُوقِنُونَ» [الطور:
35-36]، قال
ابن عباس¶: «أَمْ
خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ» أي من غير رب،
ومعناه: أخلقوا
من غير شيء خلقهم فوجدوا بلا خالق،
وذلك مما لا يجوز أن يكون؛ لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الاسم، فلا بد له من خالق فإن أنكروا الخالق لم يجز أن يوجدوا بلا
خالق «أَمْ
هُمُ الخَالِقُونَ» لأنفسهم،
وذلك في البطلان أشد؛ لأن ما لا وجود له كيف يخلق؛ فإذا
بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقا فليؤمنوا به«أَمْ خَلَقُوا
السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ»، وهذا في البطلان أشد وأشد؛ فإن
المسبوق بالعدم يستحيل أن يوجد بنفسه فضلا عن أن يكون موجدا لغيره، وهذا إنكار عليهم في شركهم بالله U،
وهم يعلمون أنه الخالق لا شريك له «بَل
لاَّ يُوقِنُونَ» أي:
ولكن عدم إيقانهم هو الذي يحملهم على
ذلك.
وكذا الاستدلال على الربوبية بعظيم خلق الله
سبحانه ودقة صنعه:
وكثيرا ما يرشد الله تبارك وتعالى عباده إلى الاستدلال على
معرفته بآياته الظاهرة من المخلوقات العلوية والسفلية كما قال تعالى « وَفِي الأَرْضِ آيَاتٌ
لِّلْمُوقِنِينَ » [الذاريات:
20] أي فيها من الآيات الدالة على
عظمة خالقها وقدرته الباهرة مما قد ذرأ فيها من صنوف النبات والحيوانات والمهاد
والجبال والقفار والأنهار والبحار،
واختلاف ألسنة الناس وألوانهم، وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى، وما
بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركات والسعادة والشقاوة، وما في تركيبهم من الحكم في وضع كل عضو من أعضائهم في المحل
الذي هو محتاج إليه فيه،
ولهذا قال عز وجل «وَفِي
أَنفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ» [الذاريات:
21]، وقال
تعالى « إِنَّ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ الَليْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَتِي
تَجْرِي فِي البَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ
السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا
مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ المُسَخَّرِ بَيْنَ
السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ» [البقرة:
164].
وختاما أقول: إن العقيدة عند أهل السنة تتميز
بالوضوح، وتدعو إلى زيادة الإيمان في القلب، لا يشبع منها من طلبها، ولا يمل من تكرارها، بخلاف كلام أهل الكلام فلا يعدو أن
يكون إلا كاسمه.
هذا، وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمن
الشيطان، والله ورسوله منه بريئان.
كتبه: وحيد قطب الصفتي.
([2]) فمدار الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله ♀
من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل.
([3])
صحيح: أخرجه
البخاري (2/938) برقم (2509) وأطرافه (3451، 6065،
6282)،
ومسلم
(4/1963) برقم (2533) من حديث عبد الله ؓ.
([4])
انظر الرسالة المدنية في تحقيق المجاز والحقيقة في صفات الله (مطبوع ضمن الفتوى
الحموية الكبرى) (ص: 4)،
و
مجموع الفتاوى (4/ 95).
([21]) صحيح: أخرجه البخاري (4/1580) (4090)، وطرفه (1331)، ومسلم (1/ 50) (19)
من حديث عبد الله بن عباس ¶.
([28]) حسن: أخرجه ابن ماجة (1/ 4) (5) من حديث أبي الدرداء ؓ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (9)، وأخرجه أحمد
وابن ماجة والحاكم بمعناه، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4369).
([44]) تهذيب شرح
السنوسية أم البراهين للإمام أبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي التلمساني (ص81
وما بعدها).
([66]) وقد كفى
فيها وشفى ما بيَّنه إمامُ السنة أبو عبد الله أحمد بن حنبل، ثم ما حرَّره
الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ثم ما حقّقه
ونقّحه شيخُ الإِسلام أبو العباس تقي الدين ابن تيمية.